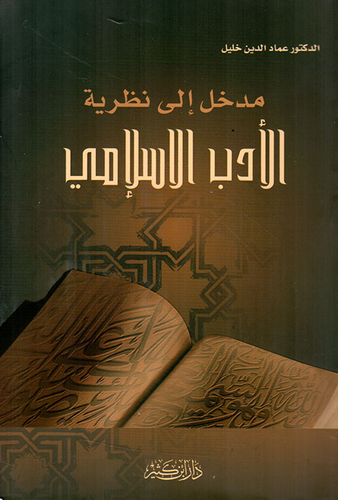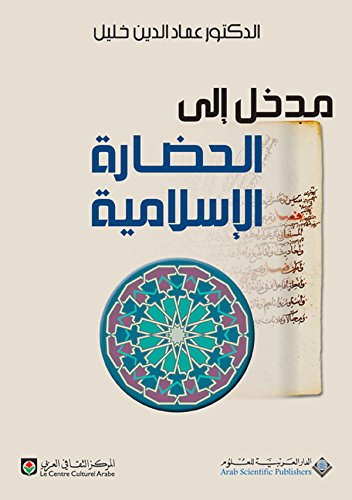حوار مع الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل
الأدب الإسلامي همومه وقضاياه
الجزء الأول
حاوره زكرياء بوغرارة مشرف شبكة وا أسلاماه وموقع ادب السجون
عندما شرعت في اعداد سلسلة حوارات مع ادباء ومنظري الادب الاسلامي ومن يحمل همومه وقضاياه هالني غياب قامات شامخة كنت اتابع كتاباتهم وادبهم شعرا ورواية ودراسة عندما سعيت في التواصل معهم بعد غيابي الطويل في السجون وجدت الكثير منهم قد رحل في صمت… والبعض منهم حاولت التواصل معه فاعتذر بعد ان اصبح طريح الفراش يئن من وطأته … ةقد أنشب في جسمد نابه الأكول
من هؤلاء الاستاذ الدكتور عماد الدين خليل الاديب الاسلامي الفذ والمؤرخ اللامع الذي وضع لتاريخ الاسلامي قواعد ونظريات وشاد صرحه بشموخ وثبات ..
فقد تابعت من زمن سحيق كتاباته الرزينة وما ابدع في الادب الاسلامي والتنظير له.. فهالني انه قد يعتذر عن الحوار نظرا لظروفه الصحية القاسية كما وصفها في موقعه الرسمي ومع هذا الخوف والخشيةمن فوات شرف محاورته ونكش ما بين جوانحه عن الادب الاسلامي وادب السجون …..القضايا والهموم
فقد سعيت لذلك جهدي وما وسعني السعي ..
ولم ألبث الا يسيرا حتى تلقيت ردا من نجله الاستاذمحمد عماد خليل الذي تواصل معي حتى تم انجاز هذا الحوار الناذر والفريد مع هذه القامة الادبية والعلمية والاكاديمية…..
نقدمه لقراء شبكة وا اسلاماه وموقع داب السجون في جزئين لتعم الفائدة
فالى الحوار
ورقة تعريفية بالدكتور عماد الدين خليل
– ولد في الموصل – العراق عام 1941م.
– حصل على البكالوريوس ( الليسانس ) في الآداب بدرجة الشرف من قسم التاريخ بكلية التربية / جامعة بغداد عام 1962م ، والماجستير في التاريخ الإسلامي بدرجة جيد جداً من معهد الدراسات العليا بكلية الآداب / جامعة بغداد عام 1965م ، عن رسالته الموسومة بـ ( عماد الدين زنكي : 487-541 هـ/1094-1146م ) ، والدكتوراه في التاريخ الإسلامي بدرجة الشرف الأولى من كلية آداب جامعة عين شمس في القاهرة عام 1968 م ، عن أطروحته الموسومة ( الامارات الارتقية في الجزيرة الفراتية والشام : 465-813هـ/1072-1410م ).
– عمل مشرفاً على المكتبة المركزية لجامعة الموصل عام 1968م.
– عمل معيداً ، فمدّرساً ، فأستاذاً مساعداً ، في كلية آداب جامعة الموصل للأعوام 1967-1977م.
– عمل باحثاً علمياً ، ومديراً لقسم التراث ، ومديراً لمكتبة المتحف الحضاري ، في المؤسسة العامة للآثار والتراث – المديرية العامة لآثار ومتاحف المنطقة الشمالية في الموصل للأعوام 1977-1987م.
– حصل على الأستاذية عام 1989م ، وعمل أستاذاً للتاريخ الإسلامي ومناهج البحث وفلسفة التاريخ في كلية آداب جامعة صلاح الدين في أربيل للأعوام 1987-1992م ، ثم في كلية تربية جامعة الموصل 1992-2000م ، فكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي ، بالإمارات العربية المتحدة 2000-2002م ، فجامعة الزرقاء الأهلية ، الأردن ، عام 2003م ، فكلية آداب جامعة الموصل 2003-2005م التي أعارت خدماته لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك – الأردن ، لفصلين دراسيين عاد بعدهما للعمل في كلية آداب جامعة الموصل حتى إحالته على التقاعد عام 2009م لكي يعيّن بعدها أستاذاً متمرساً في الكلية ذاتها. هذا إلى تعيينه أستاذاً محاضراً في قسم الدراسات العليا لكلية الإمام الأعظم في الموصل حيث لا يزال.
الحوار الجزء الاول
السؤال الأول : في البداية نحب أن نسألكم عن مفهوم الأدب الإسلامي بإيجاز ، بحيث يتضح معناه وتتكون صورته في ذهن القارئ الكريم. وما الذي يعنيه الأدب الإسلامي بالنسبة إليك ؟ وما الذي يدلّ عليه في رأيك ؟ وهل لهذا الأدب الإسلامي مستقبل ؟
الجواب : يمكن تعريف ( الأدب الإسلامي ) بإيجازٍ بالغ بأنه تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوجود … وستكون الخبرة الإسلامية المنبثقة عن التصور الإسلامي مندرجةً ضمناً في سياق هذا التعريف.
فنحن إذاً ازاء ركنين أساسيين ، يتضمن كل منهما عناصر فرعية … أولاً : التعبير الجمالي المؤثر بالكلمة ، ولابد – إذاً – أن يتحقق بالكلمة ، وليس بأداةٍ أخرى ، وأن يملك جماليته الخاصة وقدرته في الوقت ذاته على التأثير ، على توصيل الشحنة الفنية إلى الآخرين ، وإحداث الهزّة المرجوة فيهم.
ثانياً : التصوّر الإسلامي للوجود ، ولابدّ – إذاً – أن يملك الأديب المسلم فلسفة ، أو تصوراً ، أو موقفاً شمولياً ازاء الكون والحياة والإنسان ، وأن ينبثق هذا التصوّر ، الذي يطبع التجربة الذاتية طولاً وعرضاً وعمقاً ، عن الإسلام المتميز ، المتفرّد المبين.
وأي إغفال لواحد من هذين الركنين ، وأي تجاهل لإحدى العناصر الفرعية التي يتضمنانها سوف يخرج بالعمل الأدبي – ولا ريب – عن كونه أدباً إسلامياً … اننا آنذاك سوف نلتقي بشروح ( غير فنية ) لهذا الجانب أو ذاك من الإسلام تصوراً
أو سلوكاً ، وهذا ليس أدباً إسلامياً بحال من الأحوال. وقد نلتقي بعرض فني جميل مؤثر ، لكنه لا يصدر عن التصور الإسلامي ، ولا يمسه من قريب أو بعيد ، فهو ليس أدباً إسلامياً بحال من الأحوال. وقد نلتقي بعمل يتضمن قدراً من المعطيات الجمالية المؤثرة بأداةٍ أخرى غير الكلمة ، كالريشة أو الآلة الموسيقية أو الأزميل ، فهو – أيضاً – ليس أدباً إسلامياً ، ولكنه قد يكون فناً إسلامياً. وقد نلتقي بتعبير جميل عن الإسلام ، ولكنه لا يملك القدرة على التوصيل والتأثير ، لأنه لا يتجاوز الشكل إلى المضمون. ولا يعدو أن يكون زخرفاً من القول ، وليس أدباً إسلامياً.
لقد جابه أدباء الإسلامية تحدياً كبيراً والحق يقال ولكنهم قدروا على أن يجتازوه بقدر طيب من النجاح. وهاك سيلاً من الأعمال الدراسية والنقدية والتنظيرية والابداعية تخرج على الناس بكثافة تلفت النظر ، بحيث أن محاولة كتلك التي قام بها الدكتور عبد الباسط بدر ( رحمه الله ) في ( فهرسة مكتبة الأدب الإسلامي ) تضع بين أيدينا مئات المؤلفات والبحوث ، وقد وعدت بأن تضع في أجزائها القادمة مئاتٍ أخرى من الأعمال الابداعية. فماذا يمكن أن يقال عن المستقبل ؟ وهاك أيضاً … فلأول مرة في تاريخ الأكاديمية يفرض هذا الأدب حضوره في أروقة المعاهد والجامعات ، فتكتب عنه البحوث والدراسات وتقدم الرسائل والأطروحات. ويجب أن ننّبه إلى أن الدوائر الأكاديمية التي تقبل هذه الممارسة المتزايدة ، دوائر لم تكن تعترف إلى عهدٍ قريب بشيئ اسمه الأدب الإسلامي ، والأساتذة الذين يشرفون ويناقشون ويقرّون درجة ما لهذا البحث أو ذاك عن الأدب الإسلامي ، قد لا يكونون أساساً من الإسلاميين ، بل إن معظمهم من أولئك المتأثرين بتيارات النقد الغربي.
وإلى جانب هذه الدوائر فان أقسام اللغة والأدب العربي في العديد من الجامعات العربية والإسلامية قد أقرّت هذا الأدب في سياقاتها المنهجية وأعطته المساحة الواسعة التي يستحقها ، ولسوف يزيد هذا التوجه عرضاً وعمقاً الجهود القيمة التي تبذلها
( رابطة الأدب الإسلامي العالمية ) في لمّ الطاقات وبرمجتها وجعلها تصب في البؤرة التي ستمزق حجب الجهل والتجاهل ، وتضع في دائرة الضوء ، وتنمّي واحدة من أشد معطيات الإنسان الأدبية ارتباطاً بقضية الإنسان وهمومه ، وأكثرها نقاءً وطهراً ، قبالة عالم يكاد يختنق بالدنس ، وفسادٍ يلف البر والبحر والسماء بما كسبت أيدي الناس.
قبالة الهزائم والانكسارات التي عانت منها ولا تزال المذاهب والكشوف الغربية على مستوى الحياة الإنسانية … قبالة ضياع إنسانية الإنسان ودمار الإنسان نفسه في عالمٍ يحاصره السباق المحموم للتكاثر بالأشياء ، ويستنزفه الإغراق في الشهوات الهابطة ، ويلفّه سعار الالتصاق الأعمى بكل ما هو مادي … قبالة الآداب الغربية التي ارتكست هي الأخرى في حمأة الرذيلة والتفكك ففقدت وظيفتها الكبرى التي أريد لها ابتداء أن تكون بحجم الإنسان نفسه … قبالة هذا وذاك يصبح الأدب الإسلامي ضرورة من الضرورات التاريخية والإنسانية على السواء … على الأقل لتحقيق التوازن الضائع واستعادة الوضع البشري الصحيح.
السؤال الثاني : حسب اعتقادك هل يجسد الأدب الإسلامي جسراً ممتداً بين الأدب والإسلام ؟ ثم ما جوهر العلاقة القائمة بينهما ؟ وما الذي تراه في شأن رسالة الأديب المسلم ؟
الجواب : إن سلّم القيم الإسلامية التي ينشدها الأديب المسلم ، سلّم واسع المدى كثير الدرجات ، يمنح الأديب والفنان مقداراً واسعاً من الحرية والعفوية في الاختيار والتركيز دونما أي قدرٍ من التوتر والوعظية والمباشرة … إن بمقدوره أن يتحرك عبر هذا المدى الواسع لكي يقف عند هذه القيمة أو الخبرة أو تك ، حيثما وجد في وقفته تساوقاً عفوياً منغماً مع هيكل عمله الأدبي ومعطياته وجزئياته ، وحيثما رأى تناسباً وانسجاماً في اللون والايقاع والتكوين بين ما يسعى إلى تحقيقه وبين طبيعة نسيج ابداعه : لحمته وسداه.
هنالك السعي من أجل تحقيق النقاء الروحي ، وتأكيد التوازن الفعال بين العقل والروح والجسد ، بين العلم والايمان. وهناك العمل من أجل تنمية قيم البطولة وتعميق مواقف الرفض والتوازن ، يقابلها العمل من أجل التحقق بالصفاء والانسجام والاحساس الغامر بالتعاون مع سنن الكون والعالم ونواميسهما وموجوداتهما … وغير هذا وذاك الكثير من القيم التي يتحتم غرسها وتنميتها في كيان الفرد المسلم والجماعة المسلمة من أجل تعزيز شخصيتها وتأكيد ذاتها الحضارية ، وتمكينها من الوقوف على قدميها لمجابهة صراع العقائد والأفكار والدول والحضارات ، في عالم يضيع فيه ويفنى من لا يملك شخصيةً ولا ذاتاً …
هنالك – على سبيل المثال لا الحصر – ضرورات الالتزام الخلقي بمفهومه الواسع … الاستعلاء على الدنس والمغريات … تكوين النظرة الشمولية التي ترفض التجزئة والتقطيع … التوحد بين المعتقد والممارسة ، أو النظرية والسلوك … تنمية الحس الجمالي الخالي من الشوائب … تغطية الفراغ الواسع الذي تمنحه الحضارة المعاصرة بترفيه منضبط … تجاوز الرومانسية المريضة والذاتية المنغلقة من جهة ، ورفض القطيعية البكماء والجماعية الصّماء من جهةٍ أخرى … إدانة الهروب والانزواء أو الذوبان والاندماج … هناك التنمية العاطفية والوجدانية وفق طرائق سليمة … امتصاص وتصعيد الطاقة الجنسية المكبوتة … حل وتفكيك الخوف والاحساس بالنقص وفقدان الثقة … وسائر العقد والأزمات النفسية التي تجنح بالشخصية عن الحد الأدنى من السوية المطلوبة … مجابهة القلق البشري المدمر ومنح اليقين … مجابهة الاحساس العبثي الغاشم وطرح البديل الايماني في الغائية والجدوى … وهناك – فوق هذا وذاك – تحقيق الاقتران الشرطي السليم بين الفن والقيم ، وتقديم
بدائل إسلامية مقنعة لمعطيات الأدب والفنون الوضعية في ميدان القيم التربوية : البراغماتية ، الوجودية ، المثالية ، المادية … ولن ننسى بطبيعة الحال ضرورات المجابهة الابداعية لعمليات الهدم والتشويه والتدمير الصهيونية ، التي نستطيع أن نتلمس أبعادها في معطياتهم النظرية والتطبيقية على السواء.
إنه سلم قيمي واسع الامتداد ، كثير الدرجات ، ما دام أن الإسلام جاء لكي يغطي تجربة الحياة البشرية بأسرها ، في امتداديها الأفقي والعمودي على السواء ، وما دام انه كان وسيظل ، بمثابة موقف متكامل ورؤية شاملة لدور الإنسان في العالم بكل ما تتضمنه هذه العبارة من معنى … ومن ثم فان لنا أن نتصور المدى الواسع الذي يمكن أن يتحرك فيه الأديب الذي تشرب عقله وقلبه ووجدانه قيم هذا الدين.
السؤال الثالث : بنظرة شمولية نجد أن هناك تبايناً في النتاج الإسلامي للأجناس الأدبية : فالشعر يتصدر المشهد دائماً ، ثم تأتي القصة والرواية ، ثم المسرح. فهل لذلك أسباب ترونها ؟ وهل تتحقق هنا اهمية ” الكم ” ؟
الجواب : ثمة أشياء كثيرة يمكن أن تقال بالنسبة للشعر ، فهو بحق الهاجس الأكثر إلحاحاً في دائرة الأدب الإسلامي ، إذا حاولنا بحساب الكم أن نقيس الشعر على الأجناس الأخرى كالقصة والرواية والمسرحية ، ولسوف نجد يقيناً قبالة كل مجموعة قصصية أو رواية أو مسرحية ، تصدر على مكثٍ بين الحين والحين ، عشرة دواوين شعرية أو عشرين !
قد يكمن السبب في أننا أمة شاعرة ، وفي أن لغتنا – كما يقول العقاد – لغة شاعرة ، وقد يكمن في قصر الأجناس الأدبية المذكورة في تاريخ أدبنا العربي الحديث ، وما يقال – صدقاً أو كذباً – من أنها استعارة في الأغلب عن الغير ، في وقتٍ يبدو فيه الابداع الشعري ممارسة أصيلة موغلة في الزمن ، ضاربةً بجذورها في أعماق الأرض العربية ، مستمدةً تقاليدها الفنية الخصبة الغنية من معطيات مئات السنين.
ولكن هذا بحدّ ذاته قد يمثل تحدياً وآن على الإسلاميين أن يقبلوه من أجل التحقق بالتوازن في المعادلة الصعبة ، فما دام العصر الحديث في دوائره العربية والإسلامية والعالمية عموماً يتعامل مع القصة والرواية والمسرحية باهتمام بالغ ، ويضع لها مكاناً كبيراً من اهتماماته الأدبية على مستويات الدراسة والنقد والابداع ، وعلى مستوى الاستهلاك أي قاعدة القراء التي تشكل ثقلاً أساسياً في الموضوع ، فان على الإسلاميين أن يمنحوها ما تستحقه من اهتمام ، وأن يسعوا إلى توصيل قناعاتهم
وفق تقنياتها المؤثرة ذات الشعبية الواسعة والجذب النقدي الملحوظ. وهذا لا يعني
– بطبيعة الحال – دعوة للكف عن قول الشعر ، أو تحجيمه في أقل تقدير … أبداً … فليقل الشعراء الإسلاميون ما اتيح لهم القول ، وليبدعوا ما سنحت لهم منازع الابداع ، فان الساحة ما تزال بحاجة إلى مئات أخرى من الدواوين التي تحمل القضية بالقصيدة الملحمية المقاتلة ، أو الكلمة المغناة التي تعرف كيف تجتاز دروب الحس والوجدان.
ولكن الحضور الابداعي الإسلامي لن يستكمل أسبابه ، إن لم يكن هناك ، في مقابل هذا الخصب الشعري ، عطاء مؤكد متواصل ، وبالكثافة ذاتها في دائرة الأجناس الأخرى التي تقدر – ربما أكثر من غيرها – على الطرق على الآذان الصّماء والعيون التي لا ترى ، لكي تصحو فتجد نفسها قبالة أدب إسلامي سخي في الأجناس كافة ، فنقول يومها أن هناك بحق أدباً إسلامياً …
إن الأجناس الأدبية وليدة – خبرات وثقل تاريخي – إذا صح التعبير – فليس من السهولة التخلي عن نوع ما في سبيل نوع آخر ، وانما هي ماضيةً مرتبطةً بنزوع الإنسان الجمالي ، وبقدرته على التعبير ، وبالتنوع الذي هو فطرة الإنسان ، بين أديبٍ يملك القدرة على الخطاب بالصيغة الشعرية ، وآخر بالصيغة الروائية ، وثالث بلغة المسرح … وحتى في السياق الشعري هناك الصيغة الملحمية والغنائية والمسرحية … الخ وسيظل التغاير قائماً ، ولكن يحدث أحياناً لأسباب ثقافية أو بيئية ، وربما أسباب أخرى يصعب تحديدها نوع من الميل العام بين عقدٍ وآخر … بين فترة زمنية وأخرى، إلى هذا النوع الأدبي أو ذاك ويجيئ هذا – ربما – على حساب الأنواع الأخرى. وأذكر – على سبيل المثال – كيف كان عقد خمسينيات القرن الماضي عقداً شعرياً حظي فيه الشعر بالأولوية ، لكن هذا لم يغيب الأنواع الأخرى ، كالقصة والرواية والمسرح … وفي الستينيات أصبح المسرح هو الغالب ، لاسيما وأن الحركة المسرحية في مصر بلغت أوجهاً يومذاك ، وأخذت دور النشر المصرية تصدر سلاسل قيمة من الأعمال المسرحية المترجمة ، وأصبح القارئ منجذباً إلى هذه الأعمال مشدوداً إلى حضور بعضها مشخصاً على خشبة المسرح … وربما كان عقد السبعينيات عقداً للقصة القصيرة لأنها أخذت في ذلك الحين تنضج وتهندس بشكل أكثر إحكاماً من ذي قبل … أما إذا رجعنا في الزمن فقد نجد عقد الأربعينيات ساحة لأدب المقال الذي زادته انتعاشاً مجلة رائجة كالرسالة التي كانت تصدر في مصر وتوزع في كل ديار العرب … أما الرواية فأمرها يختلف ، فهي بسبب من خصبها وجماهيريتها في الوقت نفسه ، قديرةً على الحضور في كل زمن ومكان … ويزيد في ديمومتها ظهور روائيين كبار بين الحين والآخر ينفخون النار في حطبها فيزيدونها اشتعالاً … ومن منّا لا يذكر عبر العقود الأخيرة ريمارك وهيسه الألمانيين ، وماركيز واستورياس الكولومبيين ، ونجيب محفوظ والكيلاني العربيين ، وغيرهم ممن انتشرت أعمالهم في الآفاق ؟
ويظل الشعر العمودي ، بجلاله وجماله ومعماره المتناظر ، حجر الزاوية ونقطة الجذب في القصيدة العربية … انه الإرث العظيم والخصوصية المتميزة ، والفرادة ، وهوية الابداع التي يمكن أن نتقدم بها للعالم في كل زمن ومكان …
السؤال الرابع : نلاحظ كثيراً أن عدة ألقاب تسبق بعض الأسماء فهذا ” القاص والكاتب والشاعر ” ، وذلك ” الناقد والمسرحي والروائي ” … الخ. فهل : أنتم مع احتراف الأديب لفن واحد ؟ وما مدى تأثير عدم الاحترافية والتخصص على المشهد الابداعي ؟
الجواب : هذا وذاك ، فليس قدرنا أن نقول هذا أو ذاك ، فالظواهر في بعض الأحيان لا تتخاصم وينفي بعضها بعضاً وانما تلتقي وتتصالح ويعطي كل منها للحلقات الأخرى الفرصة الكاملة للتحقق.
إن الجدل ( الهيغلي ) الذي يرغم الأفكار على أن تصطرع وينفي بعضها بعضاً ، والديالكتيك المادي الذي تزيح الشرائح الاجتماعية وصيغ الانتاج خلاله بعضها البعض الآخر ، فيطرده من الحضرة ، ويستأثر بالسلطان … جدل أو اصطراع كهذا ليس قدراً محتوماً كما يخيل للكثيرين ، فهناك دائماً مع وجود الاصطراع والنفي ، الوفاق والتصالح والتوازن في هذا الجانب أو ذاك من جوانب الفكر أو الحياة.
ما أريد أن أقوله هو أن الموسوعية – إذا صحّت التسمية – لا تتعارض مع التخصص سواء في دائرة المفكر الواحد ، أو في سياق النشاط الفكري والثقافي في بيئة ما أو عصر من العصور … القطبان يكمل أحدهما الآخر … هذا يتحرك في فضاء واسع أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على خوض غماره … وذاك يوغل في أعماق الظواهر والخبرات ويتمركز في حيز محدد حيث يجد نفسه مؤهلاً لأداء مهمته الفكرية في دوائر التخصص … والحياة الثقافية التي يغيب فيها الموسوعيون ولا يتحرك سوى أصحاب التخصص في هذا الفرع المعرفي أو ذاك … حياة لا تستحق أن تعاش … أرخبيل من الجزر المنعزلة التي لا تجمعها لغة واحدة … تصوّر لو أن قرننا هذا لم يشهد مثقفين كالعقاد أو طه حسين او سيد قطب أو توفيق الحكيم أو مصطفى محمود … بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية … مثقفين كتبوا في الفكر والتاريخ والترجمة والسيرة الذاتية والتنظير الأدبي ، وابدعوا قصصاً وروايات ومسرحيات وشعراً ، كيف يمكن ان يكون … تصوّر لو أن رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي طالما مارست خطابها بلغة عقيمة سقيمة مكسّرة ، هي وحدها التي تستأثر بالساحة ، كيف يكون الحال ؟
إن التخصص هو بتأكيد من ضرورات التقدم العلمي ، في مجال الإنسانيات ، وفي المقابل فان الموسوعية هي ضرورة ثقافية … إذا كنت تملك أن تقدم شيئاً ذا قيمة في أكثر من ساحة فلماذا تتردد ؟ وإذا كان غيرك بمجرد أن يمدّ رجله خطوةً واحدةً خارج نطاق تخصصه تعرض للضياع فما ذنبك أنت ؟ ومع ذلك فان هذا لا يمنعك من أن تصير متخصصاً ناجحاً ، بل ربما أكثر قدرةً على الابداع والعطاء في مجال تخصصك ذاته من الكثير ممن اعتقلوا أنفسهم في زنزانات ما يسمى بالتخصص الدقيق ففقدوا الرؤية الشمولية واللغة القديرة على الأداء بل أصيبوا بسبب جمودهم
في البؤر الضيقة بعمى الألوان ، وغدوا – بتعبير شبنغلر – مجرد منظفي أتربة أكاديميين !
في الغرب والشرق على السواء رحل مئات الأكاديميين المتخصصين ، بل ألوفهم دون أن يسمع بهم أحد ودون أن يتركوا في الحياة الثقافية أثراً يذكر … بعضهم – إذا أردنا الحق – مضى بالخبرة العلمية صوب آفاق بعيدة ، لكن أغلبهم – والحديث مرةً أخرى عن جماعة الإنسانيات – ما فعلوا سوى أنه تمرسوا في مجال تخصصهم وأصبحوا أساتذة جامعيين ناجحين ، وليس ثمة شيئ وراء ذلك … لكن موسوعيين كهيغل وشنبغلر وتوينبي وأريك فروم وغارودي وروم لاندو ، وغيرهم كثيرون ، هم الذين أعطوا الحياة الثقافية في الغرب ، وربما في العالم كله ، طعمها وملحها … وهل ننسى جيد ومالرو وكوستلر وبرناردشو وفتكنشتاين … و … و … ؟؟
لنترك هؤلاء وهؤلاء كل يعمل في مجال قدراته التي منحه الله إياها … فكل ميّسر لما خلق له كما يقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وليس ثمة مبرر على الاطلاق لأن ينفي أحدهما الآخر ويستأثر بالميدان.
لقد فتح أبناء جيلي عيونهم على عصرٍ لم يكن المفكر فيه قد اعتقل نفسه في زنزانة التخصص ، ولقد تعلمنا كثيراً – بغض النظر عن اختلاف القناعات – من العقاد وسيد قطب وطه حسين والرافعي والحكيم وبنت الشاطئ والغزالي والسباعي والطنطاوي والندوي ومصطفى محمود وغيرهم … كانوا يكتبون في الفكر والأدب والتاريخ … كانوا ينّظرون وينقدون ويبدعون ، بل أن معظمهم قال شعراً …
ثمة مسألة أخرى … ان الساحة الإسلامية بالذات قد تغري بنوع من الملاحقة … قد تجعل الكتابة في أكثر من ميدان نوعاً من ” فرض العين ” على كل قادرٍ … وتبقى مسألة الأولويات هي التي تحدّد ما الذي ينصب عليه الاهتمام في هذه اللحظة الزمنية أو تلك.
على أية حال ، ومن أجل تجاوز أي نوع من سوء الفهم فان تشعّب الاهتمام لا يعني بالضرورة انتقاصاً لمطالب التخصص أو المنهج ، ولا خرقاً لضرورات الأكاديمية. إن ما كتبته في حقل التاريخ – ولله الحمد والمنة – يتحقق بهذه الضوابط والضرورات ، وإلا لما حصلت أساساً على الماجستير والدكتوراه ولما رقيت إلى مرتبة ( الأستاذية ) في التاريخ الإسلامي.
إن منطق العجز وحده هو الذي يدين الآخرين وهم يغادرون بين الحين والحين مواقع تخصصهم لكي يكتبوا في مجالاتٍ أخرى بعيداً عن الزنزانات التي تحاول أن تقيم أسلاكاً شائكةً بين حقول المعرفة الإنسانية.
دعني أقول لك شيئاً … إن آخر تقاليد البحث في العلوم الصرفة ذاتها تدعو إلى مشاركة الإنسان في الظاهرة العلمية … نوع من اندماج الذات في الموضوع … اقرأ ما يقوله فتكنشتاين وسوليفان وكاريل بهذا الخصوص … معنى هذا أن اتساع الفضاء المعرفي للعالم ، وكسر حاجز التخصص الدقيق عاد لكي يفرض نفسه ، ليس فقط في الإنسانيات ، وانما في العلوم المحضة كذلك.
يتبع مع الجزء الثاني