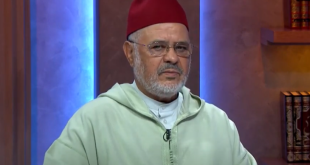كثرة النقد وقلة العمل
هشام بن عبد القادر آل عقدة
من أمراضنا الاجتماعية الذميمة: حب النقد مع ترك العمل، وقد فشت هذه الظاهرة المرضية في مختلف طبقات المجتمع؛ فلا يختص بها المثقف دون الأمي، ولا الأمي دون المثقف، ولا يختص بها الذين ينتسبون للدعوة دون من لا ينتسبون إليها، بل هي سمة في مجتمعاتنا بمختلف فئاتها.
ويكاد الكثير في مجتمعاتنا ألا يسمعوا بعالم من العلماء أو بداعية من الدعاة أو بمجاهد من المجاهدين أو بخطيب من الخطباء أو برجل بذل ما بوسعه لنصرة الإسلام أو اجتهد اجتهادا معينا لخدمة الدين، يكادون ألا يسمعوا بشيء من ذلك حتى ينصب بعضهم من نفسه مفتيا وهو على أريكته أو في منتداه أو في مقهاه ليتناول هؤلاء العاملين بالنقد والحديث مستعليا ومتعالما ومتفاصحا ومتعاظما ومستهزئا، ويملأ شدقيه بالكلام ويتفيهق ويتفلسف ويتشبع بما لم يعط، ولكن هيهات أن يعمل أو يتحرك!
أقلوا اللوم عليهم لا أبا لأبيكم أو سدوا من الخلل مخل الذي سدوا
صابرون ومساكين هؤلاء الذين يعملون ويبذلون في مجتمعاتنا؛ أولئك الذين ينقذون المواقف ويأخذون بزمام المبادرة حين يتخلف الكسالى سواء كانوا من القادرين أو غير القادرين.
قد تجد قوما لا يجدون لهم إماما يصلي بهم، ويهرب الجميع من ذلك ضعفا وعجزا لا ورعا، فإذا ما اضطر أحدهم للتقدم – إذ لا بد من هذا – تحول الهاربون إلى علماء نقاد، وذاق الإمام من ألسنتهم الأمرين، أو لا يجدون لهم خطيبا فإذا اضطر أحدهم إنقاذا لعبادتهم من التعطيل فبادر لأداء الخطبة صار الباقون على الفور أهل علم بالخطابة وكيف تكون وكيف تؤدى، وإذا نكص الناس عن الدعوة والتعليم والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فقام دعاة يؤدون ما بوسعهم تناولتهم الألسن ولاكتهم مع قلة الناصر والمعين لهم من الخلق، هكذا حالنا! لا نريد أن نكون في الميدان ولكن نحب أن ننظر من خلف الزجاج، ثم نعلق وننقد ونحلل! يثقل علينا أن نكون في ساحة العمل والبذل والعطاء ولكن نشتهي أن نشرف من وراء المكاتب! نريد أن ننقد ولا نريد أن نعمل!
فأين ذهب الذين يتكلمون بأفعالهم لا بألسنتهم وأقلامهم؟
نريد أولئك الذين تتكلم أعمالهم وبذلهم وعرقهم ودماؤهم لا الثرثارين المتشدقين المتفلسفين المتقمصين من الأدوار ما ليس لهم.
روى الترمذي بسند حسن عن جابر- رضي الله عنه -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور” . (1)
وروى الترمذي أيضا بسند صحيح عن جابر – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون”. قـالوا: يا رسـول الله! قد علمنا الثرثارين والمتشدقين؛ فما المتفيهقون؟ قال: “المتكبرون”. (2)
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيره المتفيهقين بالمتكبرين يعطينا خلاصة حال هؤلاء والدافع إلى تفيهقهم وتشدقهم وتكلفهم ألا وهو ما في قلوبهم من الكبر، وإلا فالمتفيهقون في اللغة هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، وهو مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع، فالمتفيهق يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره، ولهدا فسر النبي صلى الله عليه وسلم المتفيهق بالمتكبر، والمتفيهق بمعنى المتشدق؛ فالمتشدق هو المتكلم بملء شدقيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، وقيل: المتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم، والشدق جانب الفم، وأما الثرثارون فهم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق. (3)
فإلى متى يظل هم أحدنا الكلام والتعالم والنقد والاستعلاء على الخلق والاستهزاء بعمل العاملين؟ فهلا خفضنا من تشدقنا وتعالمنا وتفاصحنا، واتجهنا شيئا فشيئا إلى العمل!
لا نقول إن المسلم يجب أن يترك النقد كله، لكن ليكن شعارنا: “قليل من النقد وكثير من العمل”، فإن الأمة تشتكي من قلة من يعيشون لها وكثرة من يعيشون لأنفسهم، وقد وجدنا حال من يكثرون النقد وحال عموم المجتمع أنهم يعيشون لأنفسهم فيؤمنون مصالحهم أولا ويتعلقون بدنياهم ثم ينقدون الآخرين في وقت التسلية والراحة.
إذا كنت -أيها الإنسان -لا تبذل شيئا لدعوة الإسلام ولا تقدم شيئا لنصرة الدين فما لك وللآخرين الذين يقدمون ويبذلون ما في استطاعتهم! ما لك ولهم؛ فإن الإسلام أباح التيمم عند فقد الماء، وأباح إمامة الأمي لمثله؛ وتلك الصحوة التي تحمل عليها، وعمل أولئك الدعاة الذين تنال منهم بالنسبة إلى الصورة المثالية كالتيمم عند فقد الماء.
أولى بك -أيها المسلم -أن تتحرك لدينك، تحرك إن كان في قلبك إيمان.. ماذا تنتظر؟ أما أزعجك غياب شرع الله عن الهيمنة على حياتنا؟ أما أتاك نبأ الشركيات والبدع في مجتمعاتنا؟ أما أزكمت أنفك رائحة المعاصي والمنكرات في كل مكان؟ أما أعمتك المتبرجات في الطرقات؟
إلى متى تعيش لنفسك؟ إلى متى تعيش للأكل والشرب والنكاح والأولاد؟ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (الأنفال: 28).
أما بلغتك دعوته صلى الله عليه وسلم: “تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذ ن له، وإن شفع لم يشفع”، الخميصة: ثياب خز أو صوف معلمة، والساقة: الذين يحفظون الجيش من ورائه. (4)
أين دور كل واحد منا تجاه دعوة الله جل وعلا؟ أين الدافع الذاتي؟ إيمانك الذي في قلبك، ألم يحركك؟ أليس كافيا لدفعك للدعوة إلى الله؟ أين غيرتك على الدين؟ هل اكتفيت بأن اسمك معدود في المسلمين؟ ألم يأتك نبأ أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -؟! ما إن أسلم – رضي الله عنه – وعلم بما دخل فيه من دين الله – تعالى- حتى أخذ يتصل بخيار رجالات قريش، لم يجلس في بيته، ولم ينتظر تكليفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلق للدعوة إلى الدين الذي اعتنقه، وإنما أتاه التكليف من إيمانه وصدق سلامه، فأخذ يتصل بخيار رجالات قريش في مكة مرض عليهم الإسلام سرا، فأجابه وأسلم على يديه صفوة كان لها الأثر الكبير في نشر الدعوة داخل مكة وخارجها، وأفراد هذه الصفوة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة ، (5) فمنهم عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي تروج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رقية ثم أم كلثوم، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية، وعبد الرحمن بن عوف الذي دعم الدعوة بماله وجهاده، وسعد بن أبي وقاص الأمير المجاهد، وطلحة بن عبيد الله من خيرة الصحابة أيضا وأحد العشرة المبشرين بالجنة كأصحابه؛ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أولا إلى الإسلام ثلاثة رجال هم: أبو بكر وعلي وزيد، فحمل هؤلاء الدعوة من فورهم وبدافع من إيمانهم، فدعا أبو بكر خمسة رجال هم الذين سبقت الإشارة إليهم، أي أنه أسلم على يديه خمسة في وقت كان جميع من سبق فيه إلى الإسلام ثمانية رجال بالإضافة إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. هكذا يدفع الإيمان أهله لحمل الدعوة، وأنت – أخا الإسلام – كم من منحرف تعرفه ولا تفكر في دعوته وإنقاذه، وكم من شاب في مقتبل العمر بحاجة إلى من يأخذ بيده قبل أن تتقاذفه الأمواج فتتغافل عنه متشاغلا بدنياك وخصوصياتك! إن الأمة بحاجة لمن يعيش لها وينزل إليها، ويقترب من جمهورها، يسمع إليهم، ويأخذ بيدهم للثبات أمام الفتن، ويسوقهم بعيدا عن المزالق والانحرافات، ويجيبهم عن أسئلتهم، ويخرجهم من حيرتهم، ويريحهم ويمسح عنهم متاعبهم، باذلا في ذلك طاقته وجهده، وماله وراحته، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الذي كان صدرا حانيا لأصحابه، يجدون فيه طمأنينتهم وارتياحهم، والحل لمشكلاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم، فينصرف كل منهم سعيدا منشرحا. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان كل ذلك يأخذ من صحته ومن قوته. نعم كان يعيش لهم لا لنفسه، ويقتطع من صحته وقوته من أجلهم، ورضي الله عن زوجه أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها – إذ تقول – وذلك لما قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟-: “نعم! بعدما حطمه الناس”. (6) الله أكبر.. بعدما حطمه الناس أي كأنه بما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما، (7) بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة: 128).
وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد
صلوات ربي وسلامه عليه.
إن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، والذي يعيش لأمته يعيش عملاقا ويموت عملاقا.
لقد شاء الله – جل وعلا – أن يكرمنا ويتفضل علينا بأن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعيش أفرادها لأنفسهم، وإنما هي أمة أخرجت للناس، ولها وظيفة عظيمة تؤديها للبشرية {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}(آل عمران: 110). وذلك يقتضي أن يشمر أفراد هذه الأمة عن سواعدهم ليقوموا بهداية الخلق إلى الحق، إنما حياة النفس لشهواتها ورغباتها ولهوها ولعبها فلا خير فيها، يقول – صلوات الله وسلامه عليه -: “الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما”. (8)
فاحذروا من عاقبة التفريط في دوركم ورسالتكم، ولا تلهينكم شهوات نفوسكم، أو أموالكم وأولادكم عن أسباب فلاحكم ونجاتكم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (المنافقون: 9) آية عظيمة مخيفة تهز القلوب لو كان فيها حياة، لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، إنها لآية شديدة ولكنها تصور واقعنا فعلا؛ فكم تلهينا دنيانا عن ذكر الله! وذكر الله أمر عظيم وباب واسع يدخل فيه – كما ذكر الحافظ ابن القيم – رحمه الله – الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشياء أخرى عظيمة كثيرة ذكرها مع الذكر باللسان.
فاحذروا – إخوة الإسلام – أن تعطوا الدنيا أكثر مما تستحق {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} (الرحمن: 26-27) {يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (غافر: 39 – 40).
ويا ليت كل من احتوته دنياه فأقعدته عن نصرة دينه ودعوته، يا ليته خفف من طعنه في دعاة والعاملين في ظهرهم، يا ليت من فرط في حمل رسالته وفي أداء دوره تجاه الأمة.. يا ليته عاش محافظا على التزامه كما ينبغي ولم يفرط في حق نفسه.
وفي ختام هذه المقالة أذكر نفسي وإخواني بأن العاقبة ستكون وخيمة إذا ما تدرجنا في الانحدار شيئا فشيئا، فإن الأمر يبدأ بترك دورنا ورسالتنا التي شرفنا بها وجعلنا الله من أجلها {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (آل عمران: 110)، ثم ننحدر بعد هذا الكسل والتفريط فنطلق ألستنا متشدقين فلا ينجو منا العاملون والدعاة الذين حملوا الرسالة بقدر استطاعتهم، ثم ننحدر أكثر فأكثر فنترك من التزامنا شيئا فشيئا، أقول إن عاقبة ذلك لوخيمة. {فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} (غافر: 44).
نعوذ بالله من الخذلان وسوء الخاتمة، ومن خزي الدنيا وخزي يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1) – صحيح سنن الترمذي 1656.
(2) – صحيح سنن الترمذي 1642.
(3) – انظر تحفة الأحوذي، 6/161، ونقل فيه جملة كثيرة من النهاية.
(4) – انظر جامع الأصول، 9/495.
(5) – صحيح مسلم بشرح النووي، 6/12.
(6) – انظر صحيح الجامع الصغير، حديث 50.
(7) – المصدر السابق، 6/13.
(8) – حسن، صحيح الجامع، 3414. (1) – صحيح سنن الترمذي 1656.