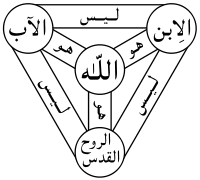الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان
الحلقة-1-
الأصل العام : دين الأنبياء واحد ، وشرائعهم متعددة ، والكل من عند الله -تعالى – .
من أصول الاعتقاد في الإسلام : اعتقاد توحد الملة والدين في : التوحيد ، والنبوات ، والمعاد ، والإيمان الجامع بالله ، وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وما تقتضيه النبوة والرسالة من واجب الدعوة ، والبلاغ ، والتبشير ، والإنذار ، وإقامة الحجة ، وإيضاح المحجة ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، بإصلاح النفوس ، وتزكيتها ، وعمارتها بالتوحيد ، والطاعة ، وتطهيرها من الانحراف ، والحكم بين الناس بما أنزل الله .
واعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها في الأحكام ، والأوامر والنواهي .
وهذا الأصل هو : ” جوهر الرسالات كلها ” .
وتفصيل هذا الأصل العقدي بشقيه كالآتي :
أما توحد الملة والدين في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين :
فنعتقد أن أصل الدين واحد ، بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين ، واتفقت دعوتهم إليه ، وتوحدت سبيلهم عليه ، وإنما التعدد في شرائعهم المتفرعة عنه ، وجعلهم الله – سبحانه – وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بذلك ، ودلالتهم عليه ؛ لمعرفة ما ينفعهم ، وما يضرهم ، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ، ومعادهم :
بُعثوا جميعاً بالدين الجامع الذي هو عبادة لله وحده لا شريك له ، بالدعوة إلى توحيد الله ، والاستمساك بحبله المتين .
وبعثوا بالتعريف في الطريق الموصل إليه .
وبعثوا ببيان حالهم بعد الوصول إليه .
فاتحدت دعوتهم إلى هذه الأصول الثلاثة :
* الدعوة إلى الله – تعالى – في إثبات التوحيد ، وتقريره ، وعبادة الله وحده لا شريك له ، وترك عبادة ما سواه ، فالتوحيد هو دين العالم بأسره من آدم إلى آخر نفس منفوسة من هذه الأمة .
* والتعريف بالطريق الموصل إليه – سبحانه – في إثبات النبوات وما يتفرع عنها من الشرائع ، من صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وجهاد ، وغيرها : أمراً ، ونهياً في دائرة أحكام التكليف الخمسة : الأمر وجوباً ، أو استحباباً ، والنهي : تحريماً ، أو كراهة ، والإباحة ، وإقامة العدل ، والفضائل ، والترغيب ، والترهيب .
* والتعريف بحال الخليقة بعد الوصول إلى الله : في إثبات المعاد ، والإيمان باليوم الآخر ، والموت ، وما بعده من القبر ، ونعيمه ، وعذابه ، والبعث بعد الموت ، والجنة والنار ، والثواب والعقاب .
وعلى هذه الأصول الثلاثة ، مدار الخلق والأمر ، وإن السعادة والفلاح لموقوفة عليها لا غير .
وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب المنزلة ، وبعث به جميع الأنبياء والرسل ، وتلك هي الوحدة الكبرى بين الرسل ، والرسالات ، والأمم .
وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” إنا معشر الأنبياء أخوة لِعَلاّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد ” متفق عليه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وهو المقصود في قول الله – تعالى – : { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب } [ الشورى / 13 ] . وهذه الأصول الكلية هي ما تضمنته عامة السور المكية من القرآن الكريم .
وإذا تأملت سر إيجاد الله لخليقته وهو عبادته ، كما في قول الله – تعالى – : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } [ الذاريات / 56 ] . عرفت ضرورة توحد الملة ، والدين ، ووحدة الصراط ولهذا جاء في أم القرآن ، فاتحة الكتاب الله – عز وجل – : { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم } ثم أتبع ذلك بأن اليهود والنصارى ، خارجون عن هذا الصراط ، فقال – سبحانه – { غير المغضوب عليهم والضالين } .
وبهذا تدرك الحِكَمَ العظيمة مما قصه الله – تعالى – علينا في القرآن العظيم من قصص الأنبياء وأخبارهم مع أممهم ؛ لأخذ العبرة ، والتفكر ، وتثبيت أفئدة الأنبياء وإثبات النبوة والرسالة ، وجعلها موعظة وذكرى للمؤمنين ، وأخبار الأمم المكذبة لرسلهم وما صارت إليه عاقبتهم ، وأنها سننه – سبحانه – فيمن أعرض عن سبيله .
والدين بهذا الاعتبار : هو : ” دين الإسلام ” بمعناه العام ، وهو : إسلام الوجه لله ، وطاعته ، وعبادته وحده ، والبراءة من الشرك ، والإيمان بالنبوات ، والمبدأ ، والمعاد .
ولوحدة الدين بهذا الاعتبار في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ، وحد – سبحانه – : ” الصراط ” و ” السبيل ” في جميع آيات القرآن الكريم .

وهذا الدين ” دين الإسلام ” بهذا أي باعتبار : وحدته العامة ، وتوحد صراطه ، وسبيله ، هو الذي ذكره الله في آيات من كتابه عن أنبيائه : نوح ، وإبراهيم ، وبنيه ، ويوسف الصدّيق ، وموسى ، ودعوة نبي الله سليمان ، وجواب بلقيس ملكة سبأ ، وعن الحواريين ، وعن سحرة فرعون ، وعن فرعون حين أدركه الغرق .
ودين الإسلام بهذا الاعتبار : هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وملتهم بل إن إسلام كل نبي ورسول يكون سابقاً لأمته ، وهو محل بعثته إلى أمته ، وما يتبع ذلك من شريعته .
كما قال الله – تعالى – : { ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } [ النحل / 36 ] .
وقال – سبحانه – : { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } [ الأنبياء / 25 ] .
وإنما خص الله – سبحانه – نبيه إبراهيم – عليه السلام – بأن : ” دين الإسلام ” بهذا الاعتبار العام هو ملته ، في مثل قوله تعالى : { قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً } [ آل عمران / 95 ] لوجوه :
أولها : أنه – عليه السلام – واجه في تحقيق التوحيد ، وتحطيم الشرك ، ونصر الله له بذلك ما قص الله خبره ، أمراً عظيماً .
ثانيها : أن الله – سبحانه وتعالى – جعل في ذريته النبوة والكتاب ؛ ولذا قيل له : ” أبو الأنبياء ” ؛ ولذا قال الله تعالى : { ملة أبيكم إبراهيم } [ الحج / 78 ] وهو – عليه السلام – تمام ثمانية عشر نبياً سماهم الله في كتابه من ذريته ، وهم : ابنه إسماعيل ، ومن ذريته من محمد عليهما الصلاة والسلام ، وابنه إسحاق ومن ذريته : يعقوب بن إسحاق ، ويوسف ، وأيوب ، وذو الكفل ، وموسى ، وهارون ، وإلياس ، واليسع ، ويونس ، وداود وسليمان ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى – عليهم السلام – .
ثالثهما : لإبطال مزاعم اليهود، والنصارى في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم – عليه السلام – فقد كذبهم الله – تعالى – في قوله : { أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون } . [ البقرة / 140 ] .
ورد الله عليهم محاجتهم في ذلك بقوله : { يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين } [ آل عمران / 65 – 67 ] .
ثم بين – سبحانه – أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين على ملته وسنته ، فقال – تعالى – : { إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين } [ آل عمران / 68 ] .
وبين – سبحانه – أن هذه المحاولة الكاذبة البائسة من أهل الكتاب جارية في محاولاتهم مع المسلمين ؛ لإضلالهم عن دينهم ، ولبس الحق بالباطل ، فقال تعالى : { وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم } [ البقرة / 135 – 137 ] .
وهكذا يجد المتأمل في كتاب الله – تعالى – التنبيه في كثير من الآيات إلى أن هذا القرآن ما أنزل إلا ليجدد دين إبراهيم ؛ حتى دعاهم بالتسمية التي يكرهها اليهود والنصارى : ” ملة إبراهيم ” فاقرأ قول الله – تعالى – : { وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس } [ الحج / 78 ] .

والخلاصـــة :
أن لفظ : ” الإسلام ” له معنيان ، معنى عام : يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من أنبياء الله الذي بعث فيهم ، فيكونون مسلمين، حنفاء على ملة إبراهيم بعبادتهم لله وحده واتباعهم لشريعة من بعثه الله فيهم ، فأهل التوراة قبل النسخ والتبديل ، مسلمون حنفاء على ملة إبراهيم ، فهم على ” دين الإسلام ” ، ثم لما بعث الله نبيه عيسى – عليه السلام – فإن من آمن من أهل التوراة بعيسى ، واتبعه فيما جاء به فهو مسلم حنيف على ملة إبراهيم ، ومن كذب منهم بعيسى – عليه السلام – فهو كافر لا يوصف بالإسلام ؛ ثم لما بعث الله محمداً – صلى الله عليه وسلم – وهو خاتمهم ، وشريعته خاتمة الشرائع ، ورسالته خاتمة الرسالات ، وهي عامة لأهل الأرض وجب على أهل الكتابين ، وغيرهم ، اتباع شريعته ، وما بعثه الله به لا غير ، فمن لم يتبعه فهو كافر لا يوصف بالإسلام ولا أنه حنيف ، ولا أنه على ملة إبراهيم ، ولا ينفعه ما يتمسك به من يهودية ، أو نصرانية ، ولا يقبله الله منه ، فبقي اسم : ” الإسلام ” عند الإطلاق منذ بعثة محمد – صلى الله عليه وسلم – حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، مختصاً بمن يتبعه لا غير . وهذا هو معناه الخاص الذي لا يجوز إطلاقه على دين سواه ، فكيف وما سواه دائر بين التبديل والنسخ . فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين : ” كونوا هوداً ، أو نصارى ” فقد أمر الله المسلمين أن يقولوا لهم : ” بل ملة إبراهيم حنيفاً ، ولا يوصف أحد اليوم بأنه مسلم ، ولا أنه على ملة إبراهيم ، ولا أنه من عباد الله الحنفاء إلا إذا كان متبعاً لما بعث الله به خاتم أنبيائه ورسله محمداً – صلى الله عليه وسلم – .
وأما تنوع الشرائع وتعددها : فيقول الله – تعالى – : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً } [ المائدة / 48 ] .
شرعة : أي شريعة وسنة . قال بعض العلماء : سميت الشريعة شريعة ، تشبيهاً بشريعة الماء ، من حيث أن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة ، رَوَى وتطهر .
ومنهاجاً : أي طريقاً ، وسبيلاً واضحاً إلى الحق ؛ ليعمل به في الأحكام ، والأوامر ، والنواهي ؛ ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه .
ويقول – سبحانه – : { لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدىً مستقيم } [ الحج / 67 ] .