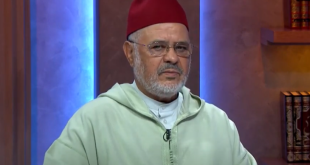(1)
من نافل القول اليوم، أن يقول قائل إن “المشكلة الإسلامية”، قد دخلت نفقا مظلماً طويلاً بارداَ، هواؤه ثقيل الوطأة، لا يكاد شعاع شمس أو بارقة ضوء أن تنفذ إليه من تكاثف ظلماته، وتراكم عراقيله وعوائقه.
و”المشكلة الإسلامية”، ليست قاصرة على واقع تعيشه أمة الإسلام، على رقعة الإسلام، كما إنها ليست حلولاً يعرضها هذا أو ذاك، يتصور بها خروجا من النفق، أو خلاصاً من الورطة. بل إن من ظنّ ذلك فقد أبعد النجعة وبالغ في التبسيط المُخلّ، الذي يورد صاحبه موارد الهلكة، لا مصادر العون.
“المشكلة الإسلامية” هي تركيبة في غاية التعقيد والتشابك، زمنياً ومكانياً، لها أصول ضاربة في عمق التاريخ البشريّ المعروف، ولها فروع تشعبت عنها، في كلّ اتجاه، على مساحة الفكر الإنسانيّ كلّه، والتجربة البشرية كلّها، فأفرزت سبلاً في طريق تلك التجربة الإنسانية، منها ما فرضته فرضاً، لقوة حجته وصحة منهجه، ومنها ما طاوعت فيه ما هو خارج عن منهحها، فألبسته رداءً كأنه من صنعها، فأورثها الضعف والتخلف.
“المشكلة الإسلامية” هي في ذلك التاريخ المعقد، الذي مرت به أمة الإسلام، منذ أن أورث الله آدم الأرض واستخلفه فيها، حتى بعث محمداً صلوات الله وسلامه عليه، ليتمم نعمته على الناس، وإلى يومنا هذا، بما حدث من تصادم حقٍ وباطل، حضارة وحضارة، فكر وفكر، جيوش وجيوش، أطماع وأطماع. وحتى بلغت الذروة في التصادم، وتداخل مجالات التأثير، منذ قرنين من الزمن.
“المشكلة الإسلامية” هي في هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، بناءً على ما أوصلنا إليه ذاك التلاطم التاريخيّ العنيف أشد العنف، المتشابك أعقد التشابك، كجمع من “دويلات” ضعيفة على كثرة عددها، متخلفة على عظمة إرثها، ذليلة على عزة مجدها، فقيرة على اتساع ثرواتها. دويلات تتعادى وتتشاكس فيما بينها، في كلّ أمر، إلا أمر التخلص من الهوية المسلمة، خلاصاً تاماً. دويلات، تحكمها طواغيت، جبارين على شعوبهم، أحذية في أقدام المستعمر المتغلب.
“المشكلة الإسلامية” هي في تلك “الجماعات الإسلامية”، كما تصف نفسها، أو كما يصفها عدوها، والتي تريد أن تصل لحلٍّ للمشكلة، من خلال مسالك متباينة أشد التباين وأكثرها تضارباً، لدرجة التعارض التام بينها، فلم تنجحأحدها، حتى يومنا هذا في تحقيق خطواتٍ جادة نحو الحلّ الشامل، إلا تقدماً محدوداً جداً هنا أو هناك.
“المشكلة الإسلامية” هي في ذلك القاع السحيق الذي وصل إليه الانحطاط الحضاريّ، أيّا كان تعريف الحضارة في مفهومك، خلقيا وماديا ونفسيا واجتماعيا. ذلك القاع الذي تتواثب فيه علينا حشرات الفكر وجراثيم التصورات وجعارين الفسق والتحلل، تعبث بكل ثوابتنا، فتصيبها في مقتل، تحت ستار الظلمة الحالكة التي هي من طبيعة القيعان، على كلّ حال.
“المشكلة الإسلامية” هي في ذلك التوصيف الذي تقيم عليه تلك الجماعات، الباحثة عن حلٍّ، إن صدقت!، تصوراتها حول ذاك التاريخ، وهذا الواقع، ثم على ما تفهمه من رسالة الإسلام، عالميتها وشموليتها وديمومتها. وهو ما نسميه “البعد العقدي” للمشكلة.
“المشكلة الإسلامية” هي في الحيرة التي وقعت فيها “الأمة”، أيّا كان المقصود بهذا التعبير الذي يختلف عليه كلّ الناس!، بين “جماعات” لها توجّهات، خطأ وصواب، حق وباطل، وبين أفرادٍ استقلوا بفكرهم، دون انتماء، منهم من نهج نهج السنة واتبع الصراط، ومنهم من اتبع السبل، فتفرقت به عن السبيل، عقديا أو حركياً، او تحليلياً توصيفياً، أو طار به الهوى كلّ مطار. ولكلٍّ رأي وحكم وعلم!، ومن ثم أتباعٌ وأنصارٌ وشيعٌ، كلّ بما لديهم فرحون.
“المشكلة الإسلامية” تكمن في خروج أمرنا وقرارنا وإرادتنا، من يدنا ليد أعدائنا، جملة وتفصيلاً، أعداء الداخل قبل أعداء الخارج. ثم في قوى العالم الظالم الكافر كلّه، تتكالب على منطقتنا، دون استثناء، وكأننا البشر الوحيد الكائن على هذه الأرض، ممن تتضارب معهم مصالح تلك القوى.
تلك هي “المشكلة الإسلامية”. وتلك هي أبعادها. وذلك هو عمقها وغورها.
فمن أراد الحديث عن حلول، فليدلى بدلوه في كلّ جانب من جوانب المشكلة، وإلا كان حلّه جزءا من الداء، لا جرعة من الدواء.
(2)
كما أشرنا آنفا، فإن النظر في “المشكلة الإسلامية”، لا يصح، ولا يستقيم على حالٍ، بالنظر في جزئيات المشكلة، على انفرادها. بل يجب اعتبارها في كلّيتها وعمومها، حيث يكون تقسيم المشكلة، سبباً في تعارض بعض أوجهها، ومن ثمّ حلولها.
لكن قواعد البحث تُملي أن يكون النظر في الجزئيات، أيسر، في البداية، لتحديد مسارات للرؤية، وكشف بعض الغائبات، وتزييف الزائف وتصحيح الصحيح. ثم لابد بعدها، وهو ما أراه غائباً في غالب الدراسات التي تُعنى بهذا الأمر، أن يُعاد ترتيب الأمور، حسب التوجهات الجديدة، ثم يعاد النظر فيها لاختيار أفضلها، وأقربها لتحقيق ما يناسب كلّ الجزئيات، أو غالبها. فإذا تمّت تلك الدورة الأولى، أُعيد النظر في مطابقة الحلول للكليَّات الحاكمة،، ثم يُرجع إلى الجزئيات مرة أخرى، للتقريب والتعديل، وهكذا دواليك، حتى يستقر الأمر على أفضل ما يُناسب الجزئيات، ويقع تحت الكلّيات.
ولا ينسى الباحث هنا، أنّ الواقع يفرض تغيّرات على الخطط والتوجهات، ومن ثمّ الحلول، فلابد من إعطائه أولوية في التركيبة المدروسة. لكن، يجب كذلك أن نعلم بأن التغيرات التي تحدث في الواقع بطيئة الأثر، موقوتة محدودة بزمان ومكان، فلا يجب أن تغير في مسار الدراسة تغييراً استراتيجياً دائم الأثر. بل يجب أن يكون التغيير على قدر ما ينعكس على الساحة لا أكثر، دون إغفالٍ أو تهويل.
وتلك العملية البحثية الدؤوب يجب أن تستمر، بلا توقف ولا كللٍ، مراجعة وتعديلاً وأصلاحاً وتقويماً. إذ عليها تقوم سلسلة التصرفات التي هي بدورها عرضة لمراجعات تكتيكية لا أكثر، من حين لآخر.
وأحسب أن تلك السياسة هي التي تتبناها، مراكز الأبحاث العالمية الغربية، التي جاءت للوجود عقب الحرب العالمية الثانية، حيث أدرك الغرب الأمريكي، أهمية مثل هذه الدراسات، وضرورتها للسير على بينة في قرارات السياسة والاقتصاد والحرب. ولا أظنّ أن تقاريرها تغرت كثيراً منذ بدأت عملها، إلا في عمق التفاصيل، ومتابعة التفاصيل اليوية لعمل بعض الرتوش الملائمة من وقت لآخر.
وقد كانت الحرب العالمية الثانية، حجر الأساس في رسم الواقع الذي يعيشه العالم كلّه اليوم، تحت السيطرة الإمبريالية الأغربية الأمريكية، حيث وضعت القارة العجوز، أوروبا، في محلها بالمركز الثاني، كما تعمل جاهدة على كبح جماح العملاق الصينيّ، الذي يهدد مصالحها الاقتصادية، لولا تفوق القوة العسكرية الأمريكية الواضح.
أما بالنسبة لنا، نحن “المسلمون”، فلا دراسة ولا غيرها، إلا ما تجود به قرائح مفكرين وكتاب ودعاة، متفرقة منبثّة في كلّ اتجاه، لا يربطها رابط من هدف، يكون قد جرى فيه اعتبار كلّ الجزئيات، وتتطابقت النتائج مع الكلّيات المنشودة، ولو دورة واحدة!
ولنضرب مثلاً ما، “الإخوان المسلمون”. منذ أن ظهر حسن البنا في مواجهة جزئية خطيرة، كانت نتيجة تراكمات لفشل جزئيات عديدة في الطريق، وهي سقوط الخلافة. فجعل همّه وبرنامجه صدى لأصلاح تلك الجزئية، وإعادة الخلافة من جديد. وقد يبدو هذا مناسباً وكافياً. لكن كما قلنا، لا هو مناسب ولا كافٍ. واستمر الإخوان يجرون بهذا الحلّ، المبنيّ على تصور أحاديّ “للمشكلة الإسلامية”، عبر الاربعينيات من القرن الماضي، وحتى العقد الثاني من هذا القرن، دون أن يقفوا لحظة لعملية إعادة نظر في مسار التحليل والدراسة والتقييم. فكان ما كان مما نحن فيه، مما لا يّخفى على أحدٍ.
كذلك، وعلى النقيض من ذلك، فإن الفكر الجهاديّ، رغم اعتباره لعدد من الجزئيات والعوامل التي تُشكّل أبعاد “المشكلة الإسلامية”، إلا أنه اضطر أن يضع العلاج، في إطار واحد، يناسب جزئيته الرئيسة، وهي الكفاح المسلح ضد الهيمنة الأمريكية المُطلقة.
كذلك قل في سائر من تحرك برغبة إصلاحية، في رقعتنا المريضة، سواء فرداً أو جماعة.
وسبب آخر في فشلنا في تلك الناحية بالذات، وهي الطبيعة العربية، على الأخص، والتي لا تُحسن عملاً حماعياً، فكرياً، أو غير فكري. فالتفرد والديكتاتورية، هي سمة الشخصية العربية، حيث يسبح كلّ فردٍ، أو مجموعة متحزبة، في فلكها، غير علبئة بما يجرى في الغرف المجاورة لها!
كما أعان على ذلك، الاستعمار الداخليّ، الذي لم يسمح بكتلة فكرية جادةٍ، تعمل بشكلٍ متكاملٍ، لوضع “المشكلة الإسلامية” في إطارها الصحيح، وتصويب أشعة الفكر الجماعيّ عليها، لتنير جوانبها كلّها، فتعيّن موطن الضعف الكامن، والمرض المزمن. ولمصلحة من يعين الحاكم العربيّ الطاغوتيّ مثل تلك التجمعات الفكرية، التي ستضعه، بلا شك، في عداد الآفات الوبيلة التي تعبث بالجسد الإسلاميّ، وترسّخ “المشكلة الإسلامية” أشدّ ترسيخاً وأكثر إعاقة.
فلم يعد إلا العمل غير الرسميّ، الذي يشارك فيه كلّ جادٍ صبورٍ صاحب علمٍ ووعي وضمير، وأهم من ذلك قلبٌ غير هيّاب، ممن يقتنع بما قدّمنا من تصورٍ عن العمل الاستراتيجي في إطار البحث عن استراتيجية فكرية وتطبيقية ثابتة، قدر ما يكون لمثلها من الثبات، فتكون جماعة باحثة، لا تُعنى إلا بالبحث والتفكيك والتركيب، ثم متابعة ذلك بلا مللٍ، وعرض النتائج على الكليات المنشودة، ثم العودة لطاولة البحث والتحليل مرة أخرى، وهكذا.
(3)
خلاصة ما تقدم أنّ دراسة “المشكلة الإسلامية”، والتي يتفرع عنها “حل المشكلة الإسلامية”، أمر خطيرٌ عظيمٌ ذو بال، بل هو أخطر مسألة تواجه العالم الإسلاميّ منذ بدأ ما يسمونه “عصر النهضة” الأوروبي، ثم توجّه الغرب لهدم الإسلام منذ الحملة الفرنسي على مصر والشام.
وهذه الدراسة، كما ذكرنا في غاية التشابك والتعقيد، إذ يتداخل فيها عشرات العناصر الهدّامة، من الداخل والخارج، تعمل للوصول إلى هدف الغرب النهائي بمحو الإسلام.
ومن السذاجة، بل من البلاهة والغرور، أن يدعي أحدٌ أنه يمكنه، وحده، أن يقوم بهذا العمل، أو أن يغطي هذه الدراسة، مهما بلغ من العلم الشرعيّ والوضعيّ. فإن استيعاب التاريخ البشريّ، بتجاربه التي فرضها الله عليه، وما كان من سير الأوائل، ثم معرفة تاريخ المسلمين، ومعاصريهم من بشر وحضارات، ثم تحليل العوامل التي وصلت بنا إلى ما نحن فيه، في كافة المجالات، ثم تحديد نقاط القوة والضعف، في عدونا، وترتيب أولويات الصراع وأفضل طرقه ووسائله، ووسائل بناء القوة اللازمة، فكريا وعملياً، ومتابعة التغيرات الحادثة على مسرح الواقع، ثم وضع الخطط لتحويل ذلك كلّه إلى قوة حقيقية واقعية دافعة … كلّ هذا، من العبث اللاهي أن يدّعى أحدٌ القدرة عليه، أو على غالبه، ولو من بعيد.
فما أردت أن أصف هنا، هو عملٌ جماعيّ طويل المدى، متشعب النواحي، يفترق ثم يلتقي، يُجمع ثم يُفرّق، حتى يكون منه محصّلة محورية، توجه المسيرة الإسلامية، في غدها، بدلاً من أن تسير سيرها اليوم، غير عارفة بطريقها، ولا مُدركة لمآلات تصرفاتها.
المطلوب اليوم، على صعوبة تصوره، لكن على ضرورة وجوده كذلك، هو جمعٌ من العلماء، المسلمين، المخلصين، المتواضعين نفساً والمتعالين خُلقاً وعلماً، الربانيين، من أهل الشجاعة والتضحية، ومن غير أصحاب الهوى أو طالبي المال أو الشهرة، يجتمعون على هذه النظرة للمشكلة الإسلامية، كما عرضتها، متوسعين في بيان مجملاتها، وتقسيم مفرداتها، ثم وضع أجزائها في يد من هو قادرٌ عليه، أمين على القيام به. ومن ثم، تُجمع هذه الدراسات والنظرات، لينظر فيها من هم على رأس هذه المنظومة، إعادة توجيهها، فكّاً وتركيباً، تجميعاً وتحليلاً، لتعود، بعد هضمها، إلى يد من يزيدها دقة وتفصيلاً.
وهذا الذي ذكرت، هو ما قام به الغرب المعتدي، في دراسته لرقعتنا الإسلامية، حضارة وديناً ونفسية وأخلاقاً وواقعاً، في مركز بحثهم، التي أدركوا، قبلنا بقرنٍ من الزمن، أنا الوسيلة الوحيدة للهدم، كما أنها الوسيلة الوحيدة للبناء. وذلك مثل معهد كارنيجي أو مؤسسة راند، التي أقيمت عقب الحرب العالمية مباشرة، ويعمل بها أكثر من ثمانمائة وألف متخصصٍ على أعلى درجات التخصص في كافة مجالات الثقافة والحضارة الإسلامية.
ثم إني أعلم أني أكاد أطلب مستحيلاً، هو أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع الممكن، لأسبابٍ عديدة، على رأسها، ترصّد عدونا بنا من ناحية، وندرة وجود من وصفت من القادرين على الانضمام لهذا العمل الجبار، الذي لا أرى غيره طريقاً للمسلمين، يخرجون به من النفق المظلم الطويل المعقد، إلى بر الاستقلال والعودة إلى المشاركة في بناء حضارة الجنس البشريّ على أسس العدالة والرحمة والتكافل، التي بيّنها الله سبحانه لنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، غير معتدين ولا ظالمين.
(4)
وتجدر الإشارة هنا أنّ هذا العمل الذي ندعو له، ونراه الشعلة التي يمكن أن تقود جمهرة شعوبنا في طريق عودتها لدينها وحضارتها وثقافتها وكرامتها، لن يبدأ من الصفر المطلق. بل الحقّ أن هناك الكثير جداً من الدراسات والأبحاث والكتب، التي وُضعت في المجالات العديدة التي عرضنا كقاعدة لدراسة “المشكلة الإسلامية”، وغطّت قدراً لا بأس به من زوايا الموضوع، على قدر الرؤية الشاملة المستوعبة لصاحب الدراسة. فأمر الإستفادة منها، والرجوع إليها، أمرٌ مفروغ منه، لا يُهمله إلا جاهلٌ بسنن التطور الحضاريّ للأمم.
لكنّ أمر تلك الدراسات والأبحاث هو أنها لم تخرج ساعية إلى هدفٍ واحدٍ مُشتركٍ، مستقرٍ في ذهن الباحث أو الكاتب، فيخرج عمله لبنة مستوية الأطراف، تسدّ مكانها في البناء المنشود. بل هي أقرب ما يكون إلى أن نعمد إلى محلاً هائلاً لتخزين اللبنات، مختلفة الأشكال والأحجام والأغراض، فنحاول أن نشيّد بها بناءً مستوياً متماسكاً، لا يخترقه ريح ولا مطر. وأنّى لنا هذا!
ثم أمر آخر ضروريّ، بل هو مفتاح ما نريد مدخلاً لحلّ “المشكلة الإسلامية”، وهو الإمكانيات المتاحة للشروع في هذا العمل، خطوة خطوة، دون عجلة أو تهورٍ، مستحضرين في الذهن أننا نتحدث عن مشروع “إحياء أمة”، لا عن إنشاء جماعة أو تجميع فصيلٍ أو تكوين منتدى فكريّ.
وقبل ذلك، فإن هناك شروط وموانع ترتبط بهذا المشروع، تختلف يسراً وعسرا، لكنها كلها ترتكز على بعض المعطيات الضرورية التي لا يمكن للوليد أن يُطلق صرخة الحياة دونها.
وهذه المعطيات، في نظرنا، هي:
• الإخلاص لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للدعوة إلى سبيل الله، دون غرضٍ أو هوى من أي نوع أو لون. وهي خصلةٌ نادرة أشدّ الندرة في عصرنا هذا، حيث أصبحت الشهرة هي الغالبة على أغراض أكثرية العاملين في هذا المجال، مع الأسف والحسرة، في عالم الإنترنت.
• الشجاعة في مواجهة الخطر، والخوف من الله سبحانه وحده، وهي، مرة أخرى، خصلة أشدّ ندرة في عصر التخابرات، وقوانين الإرهاب وملاحقة المسلمين حول العالم. وليس هذا موضع المحاضرة عن هذه الخصلة وموضعها من الإيمان، لكن يجب الإشارة إلى أنّ الخوف هو العامل الأول في تحجيم نشاط العديد من العاملين في الدعوة، حتى المخلصين منهم. ولا يعني هذا “التهور” في التصرفات، لكن عدم المبالغة في الحرص، والخوف المبنيّ على تصورات وافتراضات، للتغطية على جبن طبعيّ في المرء.
• العلم الحق المتخصص الذي يُثري صاحبه مجاله، بما له فيه من دقة فهم وعمق دراية وإحاطة بما كتب سلفه في، إحاطة استيعاب، لا إحاطة بَلّ لُعاب! فإن من الظواهر المريعة التي صاحبت عصرنا، عصر النت ومواقع التواصل، تدني العلم الحق، وقلة التحصيل الصادق والتحليل القيّم، فطفا على السطح عدد لا يُحصى من الصبيةُ والرويبضات والصغار، ممن لم يصرف لياليه في قراءة أمهات الكتب ومقابلتها وتلخيص بعضها والتعليق على بعضها الآخر، دعْ عنك قراءة ما يكتبه عدونا في لغته الأم، فهذا نادرٌ ندرة لبن العصفور، كما يقال!
وهذا العلم له علامات ودلائل ومؤشرات، على رأسها الإنتاج العلميّ الصرف، المتميّز بالجدة والأصالة وعدم النقل والتجميع. بل المقصود أن تظهر فيه شخصية العالم واضحة المعالم، تكاد تتجسد للقارئ، حنى يَعرفْه وإن لم يعرف اسمه ابتداءً. أمّا كتاب المقال اليوم، فهو فنٌ لا علم، يمكن أن يقال في أجوده أنه فنُ المقال، وهو لا يزال قليل نادر. والتفنن في القول، وإن أجاده البعض، لا يجعل منهم علماء ولا حتى طلاب علم.
• التواضع لله سبحانه، وترك الكبر والتعالي والتحاسد وإحسان الظن بالنفس فوق ما تستحق، فهذا داءٌ قتّالٌ لا يصلح معه علم ولا فن. بل يشرد صاحبه، دون أن يدرى فيه تيه كبريائه ظنّأ منه أنه لم يفارق الجادّة، وهو أبعد الخلق عنها. ثم عدم النعرة القومية التي صارت كذلك داءً خبيثاً، يسرى تحت جلد الحركة الإسلامية، أو ما يُطلق عليها كذلك! وبين أبنائها، في تدسس وخفاءٍ، تحت غطاءات مكشوفة للبصيرة، بيّنة للنظر المدققِ النافذ، مهما حاول صاحبها أن يخفيها حتى عن نفسه!
ولعل العوائق التي تقف في وجه هذه البداية تعطينا مدخلاً للنظر في الكيفية والوسيلة التي يمكن أن تكون لبنة أولى في هذا الصرح المنشود.
(5)
أما وقد وصلنا إلى هذه المرحلة، فإن مما يُستحسن هنا أن أعرض ما أراه نقطة يمكن لهذا البناء المنشود أن ينطلق منها، إلى حيث يريد ربنا أن يعلو، أو بداية لهذا الطريق أن يصل. وهي الوسيلة التي يمكن أن نتخذها، بداية لهذا الإنطلاق.
وأود هنا أن أشدد على نقطتين، عسى القارئ ألا ينساهما، أو يتخطاهما.
أولاً: أنّ أي مشاركة في هذا البناء المنشود، هو لبنة صُنعت خصيصاً لهذا الغرض، ولموضعها من البناء. وكما نوهنا، فإنّ هناك مئات الآلاف من الدراسات، لكنها كلها مشتتة الغرض، كأن صانعها قد أتمها ثم ألقاها على قارعة الطريق، لعلّ بنّاءً يجدها يوما، فيستعملها لغرضه! وكلّ تلك اللبنات الملقاة في نواحي الفكر الإسلامي، العقديّ والحركيّ، فيها خيرٌ كثيرٌ وبركة، لكنها لم تُصنع لموضعها المخصوص من هذا البناء. ولذا يمكن الاستفادة منها، حسب ما هو مناسب للبناء، لا العكس، مهما علا شأن كاتبها.
ثانياً: أن الطريق لن يكون مستقيما مُمَهّدا مفتوحاً، من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. بل يجب أن يعي المهتمون أنه لابد وأن تكون هناك عقبات كأداء في هذا السبيل، تجعل السالكين، يخرجون إلى طرق جانبية، على وعي منهم بما هم سالكوه، حتى يعودوا، مرة أخرى، إلى الطريق الأصل، معا، في كلّ خطوة، تقودهم بصيرتهم التي تعرف الهدف، ولا تعرج عنه إلى ما يعطّلها عن الوصول إليه.
والوسيلة التي اقترحها هي إنشاء مجلة علمية إلكترونية، متشعبة المناحي، تغطي الجوانب التي سردناها، أو ما طرأ لنا منها في مقالنا الأول، ثم ما يتفرع عنها من شعبٍ علمية، تكون سائرة على منهجٍ دراسيّ معروف، يتبعه كلّ باحث، في إطار وسمه الخاص في الكتابة والبحث.
وهذا اللون من المجلات كثيرٌ معروفٌ منتشرٌ، إنما المشكلة فيه هي العشوائية، وفقد الهدف، وعدم وضوح الرؤية، ثم التعددية المنهجية الواسعة النطاق، التي تجمع الشاميّ على المغربيّ، كما يُقال في المَثَل! فأبحاثهم كأنها من كلّ بستان زهرة. وإن كان منها ما هو من كلّ قطرانٍ قطرة!
لكنّ هذا يتركنا مع حقيقة أنّ الفكرة الأساسية يمكن أن تبدأ بهذه النواة. مجلة إلكترونية تُعنى بالشؤون الاجتماعية والتاريخية والسياسية والاقتصادية، العربية والإسلامية.
أهم ما يميز هذه المجلة هو الاستقلالية المادية القطعية التامة. فلا يصح، بل يَحرم تقبّل مالاً من دولة أو هيئة أو جماعة إسلامية أو غير إسلامية، أيّاً كانت، وأينما وُجدت، ولأيّ سبب كان، سواء للمجلة مباشرة أو لأحد كتّابها. وهذا التوجه لا مماراة فيه ولا محاباة ولا استثناءات على وجه القطع. هو عملٌ لوجه الله تعالى من كلّ ناحية وجانب، يقوم على أكتاف من له في الدعوة وحبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رصيد، مهما قلّ.
ومنهاج الكتابة في المجلة يضعه مجموعة ممن اتفقوا على المبدأ، من أول أمرها. وضمان اتباع هذا المنهج مسؤولية توكل إلى من يمكنه القيام بها، علماً وخبرة، دون حساسية أو كبرٍ من أحد.
ثم الأهم، في مرحلة العمل، هو “أين موضع كلّ لبنة تخرج للوجود من هذا البناء؟ وما المكلوب لتكملة فائدتها وإكمال فعالية أثرها”.
أمّا من الناحية الفنية، فهذا الأمر يحتاج إلى ترتيب وتخطيط ومتابعة على أعلى درجة من المهنيّة، خاصة خاصة بين الفروع المتشعبة للمجلة، وهو ما يطلقون عليه “interdepartmental coordination”.
وهذا الذي كتبنا، وهو قليلٌ من كثير مطلوب، يحتاجُ إلى شرحٍ مفصّلٍ، بل إلى دستورٍ مدوّنٍ، يضع الخطوط الحمراء والخضراء على السواء، ليحدّ الحدود لهذا البناء المنشود.
(6)
لن نسأم أن نردد ما قلنا بشأن ما يكتب بعض الكاتبين، تحليلا لموقفٍ حاضر، أو تأكيداً على حقائق ثابتة كالتوحيد وعناصره ومقتضياته، أو قصص من قصص تاريخنا المُلهم للشباب المتعطش لخبرٍ، ولو من الماضي السحيق، يعلّق عليه كرامته المهدرة، وأمله المرتقب. وما قلنا هو أنّ تلك الكتابات، على أهميتها، التي تخرج بشكل يوميّ تكاد تكون كلها مبتوتة الصلة بحبل الأمة الموصول بين حاضرها ومستقبلها. وإنما هي معالجة لحاضرٍ قائمٍ سواء على المسرح العربي الإسلامي أو على مستوى الفكر السلفيّ التوجيهيّ.
وكمثال نتعرف به على نوعية الكتابات الموجّهة التي يمكن أن تكون نموذجاً يفيد في الناحية السوسيوبوليتكس socio-politics (الاجتماعية السياسية)، هو ما ينشر الدكتور أكرم حجازي أو في التاريخ كما في بعض أبحاث الدكتور هاني السباعي أو الأستاذ محمد إلهامي على سبيل المثال لا الحص، أو كتابات الشيخ أبو محمد المقدسي في التوحيد، ونحن عل يقين أن هناك عشرات ممن يقوم بمثل هذا العمل في جامعاتنا ومعاهدنا، دون أن يكون لأبحاثهم انتشار أو اهتمام.
أمّا ما يصدر عن عدد من مشايخ السلفية، فهو على غزارته وعمقه وسعة مادته، مادة تعليمية، تصلح لتعليم الأفراد، في حالتهم الفردية، وليست مادة توجيهية، تكون لبنة في توجيه مجتمع مركبٍ من أفرادٍ متمايزين. والفارق شاسع بين اللونين من البحث، لمن أدرك المقصد.
ولست، بصفة شخصية، في موضع من يفرض منهجاً أو يحدد مساراً لمثل هذه العلمل. فقد ذكرت أنّ هذا لن يقوم إلا بجهد جمعيّ collective effort، ممن يرى هذه الرؤية، ويعتبر تلك المؤسسات البحثية الصهيونية، التي نجحت في اختراق وتمزيق مجتمعاتنا مثالاً للعمل الجماعيّ الساعي لوضع سياسة متكاملة ورؤية واضحة للوصول إلى هدفٍ محدد معلوم، بصبر ومثابرة وأناة وتضحية.
والأمل اليوم، أن يكون هناك، على مسرح الفكر الإسلامي الحاضر، من يشاركني هذا الهمّ، مشاركة فاعلة، لا مشاركة وجدانية أو فكرية لا غير، فيكون هناك تواصل وتخاطب، عن الهدف والوسيلة والإمكانية.
وأملي في طلاب العلم ممن هم في المرحلة الوسيطة بين التلقي والعطاء، فهم القادرون على السعي والبناء، أكثر من أمثالي ممن أفُل جيلهم وتبددت سحب غيثهم.
ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد
د طارق عبد الحليم