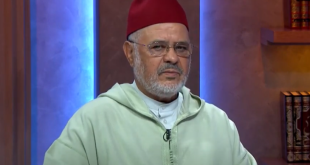زينة بالرخاء وعدّة بالشدّة”..
الصداقة بعيون التراث العربي
الصداقة في تراثنا المجهول!
“كتب رجل إلى صديق له: الله يعلم أنّني أحبّك لنفسك فوق محبتّي إياك لنفسي، ولو أني خيّرت بين أمرين: أحدهما لي وعليك والآخر لك وعليّ، لآثرت المروءة وحسن الأحدوثة بإيثار حظّك على حظّي؛ وإنّي أحبّ وأبغض لك، وأوالي وأعادي فيك”
(ابن قتيبة الدينوري في كتابه عيون الأخبار)

تنوعت مصنفات التراث العربي حول الصداقة بين التأثر بما كتبه اليونان من قبلهم بمعانٍ تجريدية أو فلسفية بحتة، وبين التجديد الكبير والمغاير لهذه المعايير اليونانية القديمة، فعلى سبيل المثال الباب الذي كتبه الأديب ابن المقفّع (ت 142هـ/759م) في كتابه “الأدب الكبير” وعنوانه “في معاملة الصديق” نراه يسلط الضوء على آداب التعامل مع الأصدقاء، فهو يقول: “اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء، وعدّة في الشدة، ومعونة في المعاش والمعاد، فلا تفرّطن في اكتسابهم، وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم”[2].
ولأهمية قضية الصداقة فإننا نرى ابن حبان البستي قاضي سمرقند في القرن الرابع الهجري (ت 354هـ/965م) المحدّث الشهير صاحب “الصحيح” يتناولها بشيء من الشرح والتأمل في كتابه الماتع “روضة العقلاء ونزهة الفضلاء”، وهذا الكتاب من نوادر الكتب الأدبية الباقية من آثاره، وهو كتاب في الحث على محاسن الأخلاق، والزجر عن مساوئها. وصفه في مقدمته بقوله: “كتاب خفيف، يشتمل على معنى لطيف، مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم من معرفة الأحوال في أوقاتهم، ليكون كالتذكرة لذوي الحجى عند حضرتهم، وكالمعين لأولي النهى عند غيبتهم… مع القصد في لزوم الاقتصار… لأن فنون الأخبار وأنواع الأشعار إذا استقصى المجتهد في إطالتها، فليس يرجو النهاية إلى غايته”[3].
يرى ابن حبان أن الصداقة أصل من أصول تكوين الإنسان النفسية والاجتماعية، ولأجل الحفاظ على هذه الشيمة الأخلاقية، والمسألة الاجتماعية شديدة الأهمية، فإن “الإغضاء”/”التغاضي” عن مزلات الأصدقاء أصل لازم من أصول استمرار هذه العلاقة، خاصة إذا لم نجد صديقا بمواصفاتنا ومعاييرنا الدقيقة، وهي نظرية شديدة الواقعية، يقول: “العاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة من لا يثق بصداقته أو صداقة من يثق بأخوته، فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته؛ بقي وحيدا لا يجد من يعاشر، فريدا لا يجد من يخادن، بل يُغضي على الأخ الصادق زلاته، ولا يناقشُ الصديق السيئ على عثراته؛ لأن المناقشة تلزمه في تصحيح أصل الوداد أكثر مما تلزمه في فرعه”[4].
وحول فضيلة “الإغضاء” و”التغافل” بين الأصدقاء دندنت مصنفات ومؤلفات هذا اللون من تراثنا، وركزت عليه، واعتبرته أصلا في ثبات علاقات الصداقة والمودة، وعدم تبدلها بمرور الأيام، وفي هذا الشأن يأتي الماوردي (ت 450هـ/1058م) بالحديث عن الإغضاء بين الأصدقاء في كتابه الماتع “أدب الدين والدنيا”، وهو إن كان كشأن معظم مؤلفات الآداب السلطانية ومرايا الأمراء في تراثنا العربي الإسلامي مجموع من الحكم، ومبوب على السجايا والأخلاق، فإنه انعكاس مهم لثقافة ذلك العصر، وتصوراته، يقول “قيل في منثور الحكم: لا يفسدنك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له. وقال جعفر بن محمد لابنه: يا بنيّ من غضب من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءا فاتخذه لنفسك خلًّا. وقال الحسن بن وهب: من حقوق المودّة أخذ عفو الإخوان، والإغضاء عن تقصير إن كان، وقد روي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى (فاصفَحِ الصفحَ الجميلَ)، قال: الرضى بغير عتاب”[5].
في رؤية فلسفية للصداقة يرى الحكيم ابن مسكويه (ت 421هـ/1030م) أن الناس يسعون في حياتهم لنيل واحدة أو أكثر من بين ثلاث حاجات، وهي الله والمنفعة والفضيلة، ويصنف ضروب الصداقة تماشيا مع هذا التصور إلى ثلاثة ضروب، وهي صداقة اللذة أو المنفعة أو الفضيلة، وهو تصنيف سبقه أرسطو إلى إقراره[6]. فعلى ذلك فإن “صداقة اللذة تنعقد سريعا وتنحل سريعا لأن اللذة متغيرة، وهي أكثر شيوعا بين الفتيان “صغار السن”… إن صداقة المنفعة تنعقد بطيئا، وتنحل سريعا بانقضاء المصلحة، وهي صداقة كبار السن… إن صداقة الفضيلة تنعقد سريعا وتنحل بطيئا لأن الخير باق بين الناس، وهي صداقة الأخيار”[7].
متاعب الصداقة دفعت الخطّابي إلى اتخاذ منحى أكثر تشددا من مسكويه في قضية الصداقة برمتها، فيرى في العزلة خير داء من الأوصاب والعلل النفسية التي تترافق مع الصداقة لا محالة |
ودعا مسكويه إلى التقليل من عدد الأصدقاء رغبة في تجنب المتاعب والمهمات والواجبات المستحقة لهم، يقول: “إن من كَثُرَ أصدقاؤه لم يف بحقوقهم واضطر إلى الإغضاء عن بعض ما يجب عليه والتقصير في بعضه، وربما ترادفت عليه أحوال متضادة، أعني أن تدعوه مساعدة صديق إلى أن يسر بسروره، ومساعدة آخر أن يغتم بغمه، وأن يسعى بسعي واحد، ويقعد بقعود آخر، مع أحوال تشبه هذه كثيرة مختلفة”[8].
ومن الطريف حقا أن يعطينا مسكويه المتوفى قبل ألف عام مجموعة من القواعد التي استفادها من أرسطو وغيره في كيفية اختيار الصديق ومعايير هذا الاختيار، وهي معايير رائقة للغاية تبدو صالحة حتى يومنا هذا، يقول: “إذا أردنا أن نستفيد صديقا أن نسأل عنه كيف كان في صباه مع والديه ومع إخواته وعشيرته، فإن كان صالحا معهم فارجُ الصلاح منه وإلا فابعد منه وإياك وإياه. ثم اعرف بعد ذلك سيرته مع أصدقائه قبلك فأضفها إلى سيرته مع إخوته وآبائه”[9].
ويبدو أن متاعب الصداقة دفعت أبا سليمان الخطّابي (ت 388هـ/998م) إلى اتخاذ منحى أكثر تشددا من مسكويه في قضية الصداقة برمتها يبديه في كتابه الذي عنوانه “العُزلة”، والعنوان خير دليل على فلسفة الخطابي الاجتماعية، فهو يرى في العزلة خير داء من الأوصاب والعلل النفسية التي تترافق مع الصداقة لا محالة، يقول: “وفي العُزلة السلامة من التبذّل لعوامّ الناس وحواشيهم، والتصوّن عن ذلّة الامتهان منهم، وأمانُ الملام عند الصديق، واستحداث الطراءة عند اللقاء، فإن كل موجود مملول، وكلّ ممنوع مطلوب”[10].

ولم يغب عن أبي حامد الغزالي (ت 505هـ/1111م) أن يُدلي برأيه في مسألة الصداقة في عدد من مصنفاته لعل أهمها كتابه “بداية النهاية” الذي استرعى فيه اهتمامنا حول هذه المسألة، فهو يرى وجوب التحقق من استيفاء الصديق لشروط الصداقة وهي العقل، وحسن الخلق، والصلاح، والكرم، والصدق، ويذكر الغزالي من حقول الصحبة الواجبة مع الأصدقاء، الإيثار بالمال، والمبادرة بالإعانة، وكتمان السر، وستر العيوب، والسكوت عن تبليغه مذمة الناس، وإبلاغه ما يسر من ثناء الناس عليه، وحسن الإصغاء عند الحديث ودعوته بأحب أسمائه إليه[11].
التوحيدي و”فلسفة الصداقة”
“قال الأديب الصُّولي: حدّثني محمد بن موسى بن حمّاد قال: سمعتُ الحسن بن وهب يقول: كاتبْ رئيسَك بما يستحق، ومَن دونك بما يستوجِب، واكتبْ إلى صدِيقك كما تكتُب إلى حبيبك”
(الصولي في كتابه “أدب الكاتب”)
يأتي أبو حيان التوحيدي (ت 414هـ/1023م) على رأس أهم من كتبوا في قضية الصداقة في تراثنا العربي، وهي نظرة ملؤها الحسرة والحنين، حسرة على عصره الذي لم يهتم بشخصية فذة ملهمة مثله، جعلته نكدا دوما، لاذع النقد دائما، وهو ما جعله يستخفي عن أنظار أعدائه لسنين عددا، ومع ذلك ففلسفته حول الصداقة شديدة الأهمية والرصانة، لأن هذه الرسالة كتبها التوحيدي على مدار ثلاثين سنة كاملة فيها عصارة خبرته، وخلاصة حكمته، تلك التي أفردها “الصداقة والصديق”.
يعتقد التوحيدي أن الصداقة عاطفة اصطفائية، وفضيلة إنسانية يصعب تحقيقها على الغالب، وهي ككل عاطفة أساسية مرتبطة بصميم الحياة الشعورية تتفرع عنها جملة من الفضائل الخلقية والسلوكية تضمن لها البقاء والنماء، فوجود هذه العناصر يساعد على تكوين الصداقة وتوسّعها وحمايتها من صدمات الحياة وتشابك مصالحها وتداخل منافعها. تلك هي الناحية الإيجابية في الصداقة، لكن هناك عناصر سلبية في هذه العلاقة مصدرها النفس الإنسانية ذاتها تفسد الصداقة وتحمل إليها بذور الانحلال كالخلاف والهجر والعتب والرياء والنفاق والحيلة والخداع والالتواء والاحتجاج[12].

يقول التوحيدي: “ليس ينبغي -أبقاك الله- أن تغضب على صديقك إذا نصح لك في جليلك ودقيقك، بل الأقمن بك، والأخلق لك أن تتقبل ما يقوله، وتبدي البشاشة في وجهه، وتشكره عليه حتى يزيدك في كل حال ما يجملك، ويكبت عدوك، والصديق اليوم قليل، والنصح أقل، ولن يرتبط الصديق إذا وجد بمثل الثقة به، والأخذ بهديه، والمصير إلى رأيه، والكون معه في سرائه وضرائه، فمتى ظفرت بهذا الموصوف فاعلم بأن جدك قد سعد، ونجمك قد صعد، وعدوك قد بعد والسلام”[13].
والتوحيدي في رسالته “الصداقة والصديق” لا يقف عند حد ذكر الأمور النظرية بل يأتي بظاهرة واقعية شاهدها بنفسه، وهي تُمثّل بنظره أسمى ما وصلت إليه الصداقة العملية بين إنسانين ممتازين بفضائلهما وعلمهما وصفائهما الخلقي والنفسي، محاولا استخلاص عناصر الصداقة المثالية على ما بين هذين الصديقين من فوارق المشاغل العقلية والمهنية والاختصاص والمنشأ[14].
قال: “قلت لأبي سليمان محمد بن طاهر السجستاني: إني أرى بينك وبين ابن سيار القاضي ممازجة نفسية، وصداقة عقلية، ومساعدة طبيعية، ومواتاة خلقية. فمن أين هذا؟ وكيف هو؟ فقال: يا بني! اختلطت ثقتي به بثقته بي، فاستفدنا طمأنينة وسكونا لا يرثّان على الدهر، ولا يحولان بالقهر، ومع ذلك فبيننا بالطالع، ومواقع الكواكب مشاكلة عجيبة، ومظاهرة غريبة، حتى إنّا نلتقي كثيرا في الإرادات، والاختيارات، والشهوات، والطلبات، وربما تزاورنا فيحدثني بأشياء جرت له بعد افتراقنا من قبل، فأجدها شبيهة بأمور حدثت لي في ذلك الأوان حتى كأنها قسائم بيني وبينه، أو كأني هو فيها، أو هو أنا، وربما حدثته برؤيا فيحدثني بأختها فنراها في ذلك الوقت أو قبله بقليل، أو بعده بقليل”[15].

ويبدو أبو سليمان السجستاني مرشدا ومعلما مهما للتوحيدي، ففي موضع آخر يسأله عما يحدث إذا تخاصم الصديقان المقربان، “وهل يُفضيان إلى هجر، وهل يفزعان إلى عتب؟ فقال: أما ما دامت الصداقةُ قاصرة عن درجتها القاصية، فقد يعرض هذا كله بينهما، لكنهما يرجعان فيه إلى أسّ المودة، وإلى شرائط المروءة، وإلى ما لا يهتك سجف الفتوة، وأما الهجر فإن حدث حدث جميلا، ولا مستمر لحوافز الشوق إلى المعهود، ومحركات النفس إلى التلاقي، وأما العتب فربما أصلح وردّ الفائت، وشعّب الصدع، ولمَّ الشعث، والإكثار منه ربما عرض بالحقد، وأحدث نوعا من النبو والبعد”[16].
ابن حزم.. تأملات في عُمر المشيب!
“يُروى أن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان أسرّ إليه معاوية بن أبي سفيان سرّا، فأتى أباه عنبسة فقال: إن معاوية أسرّ إليّ سرّا، فأحدّثك به؟ قال: لا، قال: ولمَ؟ قال: لأنّ الرجل إذا كتمَ سرّه كان الأمر إليه، وإذا أذاعه فالأمر عليه، ولا تجعلنّ نفسك مملوكا بعد أن كنتَ حرّا، قال: أفيدخل هذا بين الأب وابنه؟ قال: لا يا بنيّ، ولكن أكره أن تذلّل لسانك بإفشاء السرّ، قال: فأتى معاوية فذكر ذلك له، فقال: أعتقك أخي من رقّ الخطأ”
(محمد بن يزيد المبرّد في كتابه “الفاضل”)
تتجلى أهمية وروعة ما كتبه العلامة أبو سعيد ابن حزم الأندلسي (ت 456هـ/1064م) في مجموع “رسائله” لكونه كتبها في أخريات حياته، بعيدا عن هموم السياسة الأندلسية وآثارها المخيبة لآماله التي آلت في النهاية إلى تشرذم الأندلس إلى دويلات متصارعة “ملوك الطوائف”، فقد ترك قرطبة درة الأمويين إلى مزرعة آبائه في قرية نائية بالبرتغال اليوم متفرغا للعلم والتدوين.
وكان مما دوّنه العلامة ابن حزم في هذه الرسائل “رسالة في مداوة النفوس”، فيها أفرد الحديث عن الصداقة، وفيها لا يوطئ ابن حزم الحديث بصورة متدرجة عن أهمية هذه الصفة الاجتماعية والإنسانية وأهميتها لكونها أمرا معروفا ومفهوما، لكنه وهو في عمر المشيب ذلك يحذرك من صديقك، وكأن الأصل فيه التحول والتنكر!
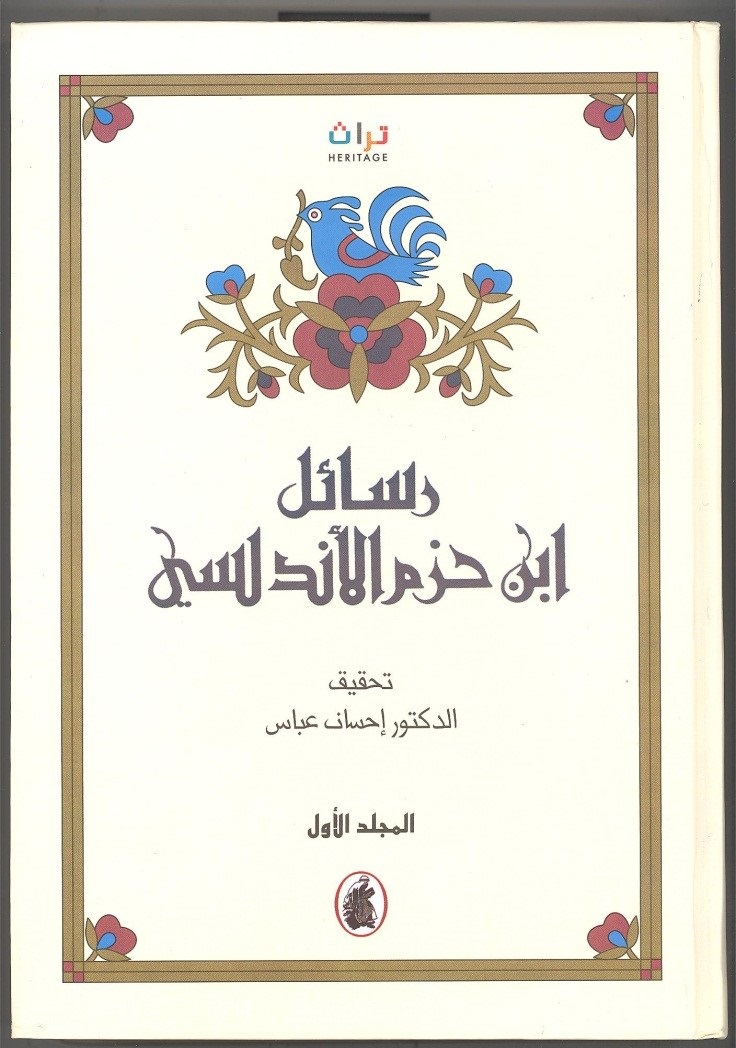
يقول: “لَا ترغب فِيمَن يزهد فِيك فَتحصل على الخيبة والخزي، ولَا تزهد فِيمَن يرغب فِيك فَإِنَّهُ بَاب من أَبْوَاب الظُّلم وَترك مقارضة الْإِحْسَان وهذا قبيح. من امتُحن بِأَن يخالط النَّاس فَلَا يلق بوهمه كُله إِلَى مَن صحِب، ولَا يبن مِنْهُ إِلَّا على أَنه عَدو مناصب، وَلَا يصبح كل غدَاة إِلَا وَهُوَ مترقب من غدر إخوانه، وَسُوء معاملتهم، مثل مَا يترقب من الْعَدو المكاشف؛ فإِن سلم من ذلك فللَّه الحَمد، وإِن كانَت الأخرى ألفي متأهبا وَلم يمت همّا”[17].
والذي دفع ابن حزم إلى إيراد كلامه أعلاه صدمته في صديق له، ظلت العلاقة بينهما قائمة على الصفاء والمودة والحب على مدار اثنتي عشرة سنة، لكن صديقه نكث العلاقة، وتحول إلى عدو لدود لسبب رآه ابن حزم “تافها” ما تصور يوما أن يكون سببا في هذا التحول.
ومن هنا يقدم ابن حزم لكل راغب في إبقاء العلائق بين الأصدقاء متينة صلبة نصيحة مهمة قائلا: “وهي أَن تكتم سر كل من وثق بك، وألا تفشي إلى أحد من إخوانك، ولا من غيرهم من سرّك مَا يمكنك طيّه بِوَجْه ما من الوجُوه، وإِن كان أخص النَّاس بك، وأن تفي لجميع من ائتمنك، ولا تأمن أحدا على شَيء من أَمرك تشفق عليه إِلَّا لضرورَة لَا بد منهَا”[18].
إن ما سبق ليعد في بحر التراث العربي ذرة مما كُتب عن الصداقة والإخاء، وهو تراث بارع يحوي دررا تحتاج إلى من يعرضها ويستكشف الحكمة منها، فالصداقة كانت في هذا التراث أصلا عزيزا قويما مهما في حياة الإنسان العربي، وقد رأينا كيف كانت وجهة نظر علمائنا بمختلف اتجاهاتهم وتخصصاتهم الفكرية بين الأدباء والفقهاء والمحدثين والفلاسفة حول الصداقة، حتى إن بعضهم أفرد مؤلفات اهتمت بهذه القضية الاجتماعية والنفسية على السواء، وكم كانوا بارعين في ذلك.
المصدر : الجزيرة