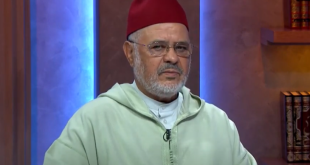بقلم : الدكتور شعبان عبد الجيِّد
في حياة الكبار من أعلام الأدب والفكر معالمُ هاديةٌ ومواقفُ مضيئة؛ تفتح لنا أبوابَ عوالمِهم، وتكشف طبيعةَ إبداعهم، وتضع أيديَنا على جوهر نبوغهم وتميزهم. إنها كلمة السر التي تحلُّ لنا اللغز، والشفرة التي تَلِجُ بنا مدنَ أفكارهم الكبرى؛ يعرفها من اقترب منهم بحبٍّ وإخلاص، ويدركها من قرأ تراثهم بتجردٍ وموضوعيةٍ وحَيْدَة، وهي تعين الباحثين عن الحقيقة، وتسهِّلُ عليهم الوصول إليها من أقصر طريق.
وليس من اليسير دائماً أن نعثر على هذه الكلمة، أو نفك تلك الشفرة؛ وبخاصةٍ إذا كان من نتحدث عنه أمةً وحدَه، أو رجلاً بألف رجلٍ كما نقول، هنالك تتعقد المشكلة، ويصبح من الصعب أن تقع على ما تريد. وهو ما لم يحدث معي حين هممت بالكتابة عن شيخي ومعلمي الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود؛ الذي تتلمذت عليه أستاذاً، وقرأت له كاتباً، ودرسته مفكراً، وعرفته إنساناً.
ولا أعتقد أن أحداً من القراء أو الباحثين سوف يعاني رَهَقاً وهو يدرس آثاره أو يتناول شخصيته؛ فهو رجلٌ بسيط وصريح، لا يعرف ازدواجية الفكر، ولا يجيد لعبة الأقنعة ـ وإن كان يفهم بذكائه المتوقد حيل الماكرين، ويعرِّي ببصيرته النافذة خبث المخاتلين ـ ويوشك أن يكون كلُّ ما كتب وأبدع عنواناً عليه ومُدخلاً إليه؛ فالأسلوب هو الرجل كما يقول الفرنسيون؛ أو قل إنه الصدق مع النفس، والإخلاص مع القارئ ، والإيمان بالفكرة ، والانشغال بالقضية.
ولعلَّ الملمحَ الأبرزَ في كتابات أستاذنا هو أنه يحمل همَّ الأمة، ويسعى إلى سعادة البشر، ويدعو إلى تحرير الإنسان. وهذه هي الدائرة الأوسع في حياة كلِّ مفكرٍ كبير، حين يتجاوز فرديته المحدودة، وعالمه الشخصي الضيق؛ فيدرك أنه جزءٌ من كل، وأنه صاحب رسالةٍ إصلاحيةٍ، تتعدَّى الذات المفردةَ إلى الجماعة الكبرى، ولا تقف بحدودها عند شخصٍ يفنى وزمنٍ ينتهي، بل تحلق في أفق الإنسانية الرحيب؛ لتأخذ بيد الحيارى والضالين، وتمد يدَ العَون إلى البائسين والمظلومين والمستَضعَفين، وتبشر بالغد الأفضل والحياة السعيدة لأبناء هذه الأرض .
وهذا ما سوف أكتفي هنا بالكلام عنه وتفصيل القول فيه، وسأتخذ من كتابه عن “الرواية التاريخية في أدبنا الحديث” نموذجاً ومثالاً.
****
عرفتُ أستاذَنا الدكتور حلمي محمد القاعود منذ ما يقرب من ثلاثين سنة؛ حين كان يدرس لنا في قسم اللغة العربية بآداب طنطا، ولا تزال علاقتي به ممتدةً إلى يوم الناس هذا. ومنذ التقيته أولَ مرةٍ، والرجلُ كما هو؛ لم تتغير مبادئه، ولم تتبدل أفكاره، ولم تتلون مواقفه؛ فهو مناضلٌ يدافع عن الحق، ومحاربٌ يقاوم الفساد، ومقاتلٌ يذود عن الحرية؛ لا تلين قناته، ولا تضعف عزيمته، ولا ينكسر قلمه؛ يواجه الفساد والظلم، ويكشف الزيفَ والقبح، ويسبح ضد تيار التفاهة والسطحية والتخلف .
ووسط الضجيج الفارغ الذي كان ـ ولا يزال ـ يصدِّع أدمغتنا ليلَ نهار، والصخب الأجوف الذي كان يُصِمُّ آذاننا ويفسد أذواقنا، جاء صوته هادئاً عاقلاً، فيه ثورة الفكر وفيضان الحكمة وغضب المنطق، وكتاباتُه ناضجةً رزينة، فيها سعةُ الأفق ، وعمق النظرة، وانضباط المنهج .
تعلَّمتُ منه كثيراً؛ أستاذاً ورجلاً؛ وأفدتُ من علمه وإنسانيته بلا حدود. كان يقول لي عن نفسه إنه مجرد طالب علم، وليس أستاذاً؛ وهو ما يذكرني بمقولة الروائي المغربي محمد زفزاف: “لستُ كاتباً، وإنما أنا مجرد إنسان، يحاول أن يعطي انطباعاته عن هذا العالم مثلما سبق للآخرين أن أعطَوا انطباعاتهم”. ولم يزعم أبداً أنه ينطق بالصواب المطلق أو أنه دائماً على الحق المبين. يعرض أفكاره ولا يفرضها، ويراجع الرأي ويناقشه ويمحصه، ويعود إلى الصواب إذا رأى أن العودة حق، ويبقى على موقفه إذا لم يجد من المسوغات ما يدعوه إلى التخلِّي عنه.
***
• إنسانٌ بسيط :
وهو إنسانٌ بسيط ؛ ولد في القرية، وعاش ولا يزال يعيش فيها؛ لم تجذبه أضواء المدينة ، ولم يخدعه بريق الشهرة، وظل مقيماً بها؛ يتعلم منها، ويتواصل مع العالم من خلالها. ولعله تأثر في هذا بصديقه الدكتور عبد السلام العجيلي ، الروائي الأول في سوريا، والذي لم يفارق قريته الصغيرة (الرَّقَّة)، وهو الوزير والنائب في مجلس النواب، يذهب إلى دمشق، ويعود إلى قريته ليمارس الطب حرفةً والأدبَ هوايةً ، حتى وهو في التسعين.
اشتغل بمهنة التدريس، ودرّس في مراحل التعليم المختلفة: الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدراسات العليا، وأسهم في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر وفي غيرها، وعمل ببعض الجامعات العربية، وكان يؤدي عمله في كل هذه الأماكن في بساطةٍ وسلاسةٍ شديدتين؛ لأنه في الحقيقة ـ وكما عرفته ـ رجلٌ بسيط ، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويرضى ، ويرتضى لنفسه، أن يكون مواطناً بسيطاً، وأن يعيش في مجتمعٍ بسيط ؛ لا يعرف التعقيد ولا التركيب ولا التكلف.
كانت القرية بالنسبة إلى أستاذنا هي المنبع والمصب، ونقطة الانطلاق والعودة، فمنها يخرج وإليها يؤوب؛ إنها المبتدأ والخبر على حد قوله؛ بيد أن تمسكه بها وسكنه إليها واستقراره فيها، لم يمنعه من أن يدخل (الدائرة الصعبة)، دائرة الإبداع والكتابة والنشر، بَيْدَ أنه صمم حين أدركته حُرفةُ الأدب أن يظل كما هو؛ يتردد على القاهرة ومنتدياتها، يراقب ويلاحظ ويشارك، دون أن يفرط فيما بداخله من قيم، أو يتخلى عما نشأ عليه من أصول ؛ فهو لا يندمج ولا ينخرط ولا يذوب، ولا يسمح أبداً أن يلغي شخصيته أو يتنازل عما يميزه. وهو إلى الآن لا يزال يتحدث بلهجته الريفية المحببة ؛ لا يجد في ذلك غضاضةً ولا يرى فيه منقصة.
***
• المحارب!
الريفيُّ عنيدٌ بطبعه؛ وهذا عنوان فحولةٍ وسيماء رجولة؛ لا يضعف أمام النوازل، ولا يستسلم للشدائد؛ بل تزيده النكبات عزماً وصلابة. وقد فعلت القرية في شخصية أستاذنا فعلها وتركت في أخلاقه أثرها، ثم جاءت تجربته الإبداعية والإنسانية الكبرى حين التحق بالجيش المصري مجنداً بعد هزيمتنا في يونيو 1967 م، وحتى انتصارنا في أكتوبر 1973 م. ليقضي فيه ست سنواتٍ ملآنةً بالشجن والأسى، ومزدحمةً بالأعاصير النفسية والتقلبات الفكرية ، وليبدع من خلالها مجموعته القصصية: “رائحةُ الحبيب”، وروايته “الحب يأتي مصادفةً”، ويصور من خلالهما آثار الهزيمة وآلام النكسة.
وكان عليه حين دخل ساحة العراك الأدبي والصراع النقدي، أن يكون مسلحاً بعدة المحارب: صفةً وفعلاً؛ فمنطقة النقد الأدبي أيامها كانت ـ ولا تزال ـ مشتعلةً وملتهبة، والنقد بطبيعته التقييمية والتقويمية مزعجٌ للناقد والمنقود على السواء؛ ونادراً ما يُبْقِي لك صديقاً، لأن صاحب النص الإبداعي يريد منك ثناءً وتقريظاً ومدحاً؛ وإلا فأنت متهمٌ في مقاصدك أو جاهلٌ بأسرار الفن. ولا يصبر في هذا الميدان إلا أولو العزم من أصحاب الهمم العالية والإرادات الجبارة ؛ وأستاذنا حلمي القاعود في المقدمة منهم ، وإن أنكر هو ذلك حين قال لي ذات يومٍ: إنني لا أعد نفسي منهم ، ولعلها من السذاجة الريفية أن أستمر في هذا الميدان، وأن أشق فيه طريقاً تختلف عن التي كانت سائدةً في ذلك الحين!
في تلك الفترة كان مدُّ الأدب الاشتراكي والنقد الواقعي قد بلغ مداه، على حساب التيار الرومانسي والاتجاه الكلاسيكي؛ وكانت المنابر الثقافية والمؤسسات الصحفية تتأثر بتوجهات المسئولين عنها وطبائع القائمين عليها؛ وكان على من يريد أن يكون له فيها موضع قدمٍ أن يركب الموجة، ويجري وراء القطيع؛ ولقد فعل ذلك كثيرون، وظل أستاذنا قابضاً على الجمر، يبحث عن كل أصيل، ويدرس كل جميل، لم يُلْقِ بنفسه في حبائل الشكل، ولم يُدِرْ ظَهرَه لروعة المضمون ، وتعامل مع الأعمال الأدبية التي يتناولها بالمنهج التكاملي الذي يركز على (النصِّ) تحليلاً ووعياً وفهماً .
***
• الأدب الإسلامي:
بعد ذلك، وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ظهرت حالةٌ من الانفراج الفكري والسماحة التعبيرية، وبدأ يتساءل عن أدبٍ يعبر عن التصور الإسلامي، وكتب مقالاً قصيراً عن هذا، اشتعلت على أثره الساحة الأدبية، وانقسم الناس فيه إلى مؤيد ومعارض، وذهب فريق منهم أن ما يطلبه ويبحث عنه هو الأدب الذي يسجل التاريخ الإسلامي ، وكتب الأستاذ عباس خضر رداً على هذا المقال “بل هو أدبٌ موجود”، ولكنه تكلم عن روايات جورجي زيدان التاريخية، بينما كان الدكتور حلمي يبحث عن شيءٍ آخر تماماً؛ عبرت عنه رابطة الأدب الإسلامي بعد ذلك بنحو عشر سنوات.
وكان أكثر الناس يفهمون “الأدب الإسلاميَّ” على أنه الوعظ والإرشاد والتوجيهات المباشرة للجمهور؛ أمَّا أستاذنا فإنه يتكلم عن شيءٍ مختلف؛ وهو “التصور” الذي يظهر فكرة الكاتب ويبرز رؤيته للعمل من منظورٍ إسلامي، سواءٌ في الشعر أو في النثر. وإذا كان الإنسان المسلم الحقيقي هو أكثر الناس التزاماً بما يؤمن به، فكراً واعتقاداً وسلوكاً ، فإن الأديب المسلم الحقيقي هو أكثر المسلمين التزاماً بما يؤمن به ، فكراً واعتقاداً وسلوكاً.
وقد ذهب في كتابه عن “إنسانية الأدب الإسلامي” إلى أن الأدب الإسلامي حركة تجديد للأدب العربي الحديث والمعاصر وآداب الشعوب الإسلامية الأخرى، حيث يستعيد هذا الأدب للأمة هويتها الضائعة وخصائصها المطموسة بفعل تأثيرات صاخبة وعواصف عاتية، هبت من هنا وهناك لتنال من تماسك المجتمع العربي والإسلامي وتستبدل قيماً بأخرى.
أما إذا كنا نقبل من الأديب أن لا يلتزم بالإسلام، وبما افترض الله عليه في سلوكه وعمله وتفكيره ، فإننا حينها ـ على حد تعبير الأستاذ محمد حسن بريغش في كتابه (في الأدب الإسلامي المعاصر: دراسة وتطبيق) ـ لا نعجب إن رأيناه يدعو للآثام باسم الفن، ويروج المنكر والفساد باسم الأدب، ويقبل المحرمات ويقترف الآثام باسم الضرورات والعصر، ويخلط في التفكير والمنهج باسم الموهبة والإبداع .
وهذا ما يفسره ويوضحه قول أستاذنا في مقالته عن “الشخصية الإسلامية في أدبنا الحديث” حين قال: “إن واقع الحياة يحفل بالشخصيات السوية والمنحرفة، والطيبة والشريرة، ومن غير الإنصاف، أن نزيّف الواقع، فلا نرى فيه إلا الشر والقبح والدمامة، وأن نصوّر الشخصيات الإسلامية تصويراً يتسم بالمغالاة والبعد عن الواقع، فلا نرى المسلم إلا صاحب وجهين ومنافقاً وانتهازياً وأفَّاقاً، وإذا كان بعض المعادين للإسلام يتسقون مع أنفسهم في هذا الاتجاه، فإن المسلمين الذين يسايرونهم يضعون أنفسهم في موقف الريبة والشك “.
أيامَها كانت الروايات التي كانت تُكتَب من منظور إسلامي قليلةً جداً، فدعا أستاذنا إلى إبداع الرواية التي تتمثل روح الدين وتصور أثره في نفس المؤمن وأخلاقياته ، وهو ما استجابت له رابطة الأدب الإسلامي بصورةٍ عملية حين أعلنت عن مسابقات لكتابة الرواية الإسلامية؛ وبرع فيها حينئذٍ القاص المغربي الناشئ إسلام أحمد إدريسو صاحب رواية (العائدة).
ومن الطرائف أنه كان في إحدى الكليات لمقابلة بعض الطلاب المرشحين للعمل معيدين؛ ويُفترض فيهم أنهم متفوقون ونابهون، فسأل أحدَهم: هل قرأت رواية؟ فسكت. وأعاد عليه السؤال مرةً أخرى فلم يجب، فقال أستاذنا: ألم يدرِّس لك فلانٌ وفلان؟ فقال: بلى! فسأله: وماذا درَّسوا لك؟ فقال: درَّسوا لي نجيب محفوظ وعلي أحمد باكثير، وعبد الحميد جودة السحار؛ ولما سأله : فلماذا لا ترد إذن؟ أجابه بأن أحد الشيوخ قد سئل هذا السؤال فسكت. فضحك الدكتور حلمي وقال له: يا بني إننا إذا لم نقرأ الروايات وندرسها فلن نأكل خبزاً !!
ويحدثنا أنه كان يتابع عن كثبٍ كل ما يدور في الساحة الثقافية في تلك الأيام، ودفعه هذا إلى أن يضع مؤَلَّفَه الرائد عن “الصحافة المهاجرة” إلى لندن، وقبرص؛ وهو أول كتاب يعالج هذه الظاهرة التي أملت عليه أن يكتب عنها ويكشف أبعادها الغائمة، بَيْدَ أنه لم يتوسع في هذا المجال، وما لبث أن استغرقته الصحافة الإسلامية التي كان لها في أوائل السبعينيات منهج تقليديٌّ؛ يقوم على معالجة القضايا المكرورة والنظر إلى بعض الأمور التي لا تهم الجمهور ولا تعنيه، وكان من رأيه في هذا المجال أن نناقش المشكلات اليومية التي يعيشها الناس، والقضايا المطروحة على الساحة الفكرية، وعلى رأسها قضية “تطبيق الشريعة الإسلامية”.
وكان تطبيق الشريعة ـ حتى في نظر النخب الثقافية ـ مقترناً ومرتبطاً بالحدود وحدها، وهي عندهم قطع الأيدي ورجم الرجال والنساء، ولا شيء غير هذا؛ فحاول، هو ومجموعةٌ من الكتَّاب الفضلاء، أن يغيروا تلك النظرة الضيقة، ويقدموا الصورة السمحة لمعنى التطبيق ، ويؤكدوا بالدليل والبرهان أن الرسول بُعِثَ هدايةً ورحمة للعالمين، وأن الشريعة ليست هي الحدود فحسب؛ وإنما هي رسالةٌ ومنج حياة، يقوم على الرحمة والمودة والتكافل والمساواة؛ وقبل ذلك وبعده على الحرية.
***
• موقفه من الحداثة :
الحداثة (Modernity) كلمةٌ خادعةٌ ومراوغة، وحمالة أوجه؛ يصيب من يستخدمها بمعنى التطوير والتجديد، ويخطئ من يظن أنها تنكرٌ للماضي، وتمردٌ على الأصول، وانخلاعٌ من الجذور. وهي كلمة أجنبية وافدة تعني الثورة الكاملة على كل ما كان وما هو كائن في المجتمع؛ ودلالتها في الغرب مرتبطة بجملة من الظروف السياسية والاقتصادية والفكرية، ولا يعني هذا أن نأخذ بها ضربة لازب، فأكثر ما يأتي من الغرب لا يسرُّ القلب، وهي غالباً ما تعني عندهم الانقطاع عن الماضي والانفصال عن التاريخ، أي أن تتخلى عن كل ما سبق، وتنشئ لك عالماً جديداً، وفق تصوراتك البشرية، فتلغي الوحي وتنكر الغيب وتكفر بالأديان.
ويرى الدكتور حلمي أننا لا نرفض أن نتقدم وننطلق إلى الأمام، ولا نستنكف أن نتفنن ونبتدع. ولكن البعض طرح قضية الحداثة من المفهوم الغربي، وهو لا يتوقف عند حدود التطوير في الأدب ولا يكتفي بالتجريب في الإبداع، ولكنه يفرض مذهباً فكرياً بغيضاً ؛ كان عنوانه البارود والغزو، ومن آثاره التخريب والتدمير.
إن هذه الحداثة كما يقول أستاذنا قد انطلقت لتغزونا وتضربنا، وهي بداية عصر الاستعمار الحديث، ولم ينظر أكثر المشتغلين بها إلى مفهومها الغربي؛ مع أن الحداثة انتهت هناك، وما بعد الحداثة انتهى أيضاً، وكتب فوكو ياما نفسه مقالاً يتراجع فيه عم فكرة “نهاية التاريخ” التي كان قد روَّج لها كثيراً، وذهب إلى أن أمريكا تقود العالم بمنطق الإمبراطورية الكبرى.
وخلاصةُ الكلام أننا في حاجةٍ إلى التحديث؛ لأنه سنة الله في خلقه، وهو ضرورة بشرية يفرضها الواقع وتستوجبها الحياة؛ أما ما يتعلق بالروح والقيم والهوية فهو أمرٌ له حساباتٌ أخرَى، وهو ما لا يجب أن نفكر في التنازل عنه أو نقدِم على التفريط فيه .
***
• الواقع الثقافي :
لعل أكثر ما يميز أستاذنا حلمي القاعود هو جرأته في الحق، وشجاعته في إبداء الرأي؛ فهو لا ينافق ولا يداهن، ولا يجامل ولا يتملق؛ يقول كلمته لله وللتاريخ، ولا تمنعه هيبة الناس أن يقول بحقٍّ إذا علمه؛ فالرجل الكريم لا يكذب قومه، وليس من المروءة أن نرى الفساد فنجمِّله، ونبصر الظلم فنستحسنه، ونبيع ما عند الله بما عند الناس.
وانظر إليه وهو يجيب من سأله عن رأيه في الواقع الثقافي المعاصر ، وبخاصة ما يتصل منه بالحياة الأدبية؛ حيث يقول بصريح العبارة: “إنه واقعٌ فاسد؛ لأنه يحارب الثقافة الوطنية والقومية والإسلامية، ويدعو إلى الثقافة الاستعمارية وخاصة في جوانبها السلبية: تسليع المرأة، تفتيت الأسرة، رفض التشريع الإسلامي في الأحوال الشخصية، الدعوة إلى الإباحية، رفض وجود ثوابت في الإسلام، محاربة الحجاب، الدعوة إلى التبعية للغرب الرأسمالي، تصفية القضية الفلسطينية لحساب العدو النازي اليهودي، التقليل من قيمة القدس العتيقة، التشهير بالجهاد والحركات الإسلامية المقاومة في فلسطين، الدعوة إلى إخراج التصور الإسلامي عن مجال القضية الفلسطينية.. وهكذا..
وفي المجال الأدبي، يتم الإلحاح على قضيتين أو مسألتين: الأولى الترويج للإباحية في الأعمال الإنسانية، والأخرى: التشجيع على الطعن في المقدسات الإسلامية بحجة كسر (التابوهات)، ونلاحظ أنهم لم يقتربوا من “تابو” السياسة أبداً؛ لأنهم يعرفون المصير الذي ينتظرهم! لذا لم نر أدباً تنشره المؤسسة الرسمية ذا قيمة في الأغلب الأعم.
حتى مكتبة الأسرة فرغوها من مضمونها، ونشروا كتباً معظمها تافه أو محدود القيمة، لتحقيق أغراض شخصية، أما الكتب الجيدة والمهمة فقد كانت قليلة، ولجأوا أحياناً إلى تشويه بعضها، بالحذف، كما جرى لكتاب “وحي القلم” لمصطفى صادق الرافعي.
ولا تنسَ أنهم في مجال النقد الأدبي ألحُّوا على مذاهب الحداثة وما بعدها مثل البنيوية والتفكيكية والشكلانية والنسوية والنقد الثقافي، وهي بنت بيئتها التي لا تتلاءم مع أدبنا وظروفنا، وتغتال المعنى اغتيالاً تاماً في معظمها لحساب ثقافة وحشية مدمرة، ولعلك قرأت كتاب “الخروج من التيه- دراسة في سلطة النص” لعبد العزيز حمودة، الذي صدر قبل شهور في سلسلة “عالم المعرفة”، إنه يفضح هذه النظريات ويكشف تهافتها وتهافت من يروجون لها في واقعنا الثقافي، الذي صار فاسداً في مجمله، غريباً عن فطرة الشعب والأمة جميعاً”.
كان هذا الواقع الثقافي الفاسد هو الذي حدا بأستاذنا أن يكتب كتابه الممتع الموجع عن “الورد والهالوك”؛ وهو من الكتب التي كتبها بدمه كما يقول؛ وقد واجه فيه وحده تياراً هادراً يملك كل شيء، الصحافة والإذاعة والتلفزيون والمؤسسة الثقافية بكتبها ومجلاتها وصحفها، وندواتها ومحاضراتها وجوائزها، ونقادها ومؤتمراتها، وكان الترويج لأفراد هذا التيار لا يتم داخل الحدود وحسب، ولكنه كان يتجاوزها إلى أرجاء العالم العربي والصحف والمجلات ودور النشر في لندن وباريس وقبرص، وتاهت الحقائق، وضاع الفن، وسط الضجيج الصاخب الذي يروج لشعر يخلو من مقومات الشعر شكلاً وموضوعاً، بل تعدى إلى إهدار كل قيمة مضيئة فنياً وإنسانياً، في الوقت الذي تقوم فيه كوكبة من الشعراء على امتداد قرى مصر ومدنها الصغيرة بدور صامت في التعبير عن هموم الأمة من خلال فن جميل أصيل متجدد، دون أن يلتفت إليها أحد، أو يقدرها أحد.. وهنا كان دوري لأواجه التيار وأسبح ضده، وأنشر الحقيقة، وقلت رأيي واضحاً وصريحاً وجريئاً بفضل الله، وصح كل ما توقعته. واليوم لم يبق إلا شعراء الأصالة.. أما الهالوك فقد جف وأصبح هشيماً تذروه الرياح.
وهكذا الرجل في كل ما كتب ؛ يحاول دائماً أن يضع يده على الحقيقة، ولا يعبأ أبداً بالضريبة التي يدفعها ـ وكثيراً والله ما دفع ـ المهم أن يكون هناك رأي فني مخلص، ولتكن النتائج ما تكون !
ولقد حدثونا منذ سنين طوالٍ عن ثلاثية الفقر والجهل والمرض؛ وشغلونا بها دون أن يقدموا لها حلولاً واقعيةً أو يصفوا لها علاجاً قابلاً للتطبيق؛ فزاد الفقر وعم الجهل واستشرى المرض، وظهرت ثلاثية أخرى أسوأ أثراً وأفدح ثمناً وأشد تنكيلاً ؛ وهي ( ثلاثية الاستبداد – القهر – التخلف) التي وضع عنها الأستاذ كتاباً في مائتين وثلاثين صفحةً ، وقال إنها تمسك بخناق الشعب ، والأمة ، مما أعطى لأعدائنا وخصومنا فرصة العمل “الآمن” داخل أوطاننا ، وصرنا “معرّة الأمم” ، لولا ومضات تبرق هنا وهناك تبشر بالأمل والعمل والمقاومة والتضحيات ، وهو ما يضع على عاتق شعوبنا مهمة صعبة وشاقة في مقاومة الاستبداد والقهر والتخلف جميعا ..
ويضيف أستاذنا أننا شهدنا على مدى عامي 2004، 2005م، حراكاً سياسياً ملحوظاً ، ولكنه كان قاصراً على نخبة محدودة، دفعت ثمناً باهظاً لمواقفها، في ظل قسوة بوليسية مفرطة ، وتهالك إداري واضح ، وفساد غير محدود، وكذب مفضوح تقوم به أبواق مأجورة من مثقفي السلطة وكتابها، ومع توالي الكوارث والمصائب التي تصيب المصريين مثل غرق العبارات، وتصادم القطارات ، والإصابة بأوبئة الطيور والحيوانات …. فإن الأمور في حاجة إلى استنهاض الهمم واستثارة العزائم لمعالجة أوضاعنا المتردية والانهيار الاجتماعي الاقتصادي الثقافي التعليمي التربوي.. والعلاج يبدأ بوصفة بسيطة جدا وسهلة للغاية أسمها: “الحرية” .. وبالحرية يمكن أن نبني وطناً حقيقياً، وأمةً واعدة.
***
• كيف يكتب ؟ :
تخيلت نفسي ذات يومٍ وبين يديَّ كل ما كتبه الدكتور حلمي القاعود من خواطر ومقالات ، ومباحث ودراساتٍ، وكتبٍ ومؤلفات؛ فسألت نفسي بعد العجب والدهشة والانبهار: كيف تسنى للرجل أن يسطر كل هذا؟ ومن أين جاء بالوقت والطاقة ليقرأ ويفكر ويكتب؟ وتذكرت رفاقه وإخوان طرازه من الأدباء المنشئين والكتاب المكثرين؛ وعادت إلى خاطري عبارةً كنت قد قرأتها عن أحد النقاد الغربيين، ذكر فيها بأنه أخذ على نفسه عهداً بأن يكتب كل يوم عشر صفحات ، وظل يفعل ذلك لأكثر من أربعين سنة!
ولكن ذلك كله لم يقنعني؛ وأردت أن أعرف منه حقيقة أمره في الكتابة والإبداع؛ وهو الزوج والأب والأستاذ الجامعي، الذي لا يجد وسط زحام المشاغل والشواغل وقتاً ليلتفت حوله، وسألته غير مرة: كيف تكتب يا أستاذنا؟!
وكانت إجابته تدور دائماً حول نقاطٍ محدَّدة:
• النظام وترتيب الأفكار.
• الصبر على متاعب القراءة والكتابة .
• المثابرة على العمل المستمر والجهد الدءوب .
• معرفة قيمة الوقت وتقديره.
• وضع خطة يومية (تشبه الوِرد اليومي) للقراءة والتأمل والكتابة.
• تبني مشروع فكري وثقافي واضح المعالم والتفاصيل.
• العمل بروح الهواة وأسلوب المحترفين.
• التضحية بالملذات الصغيرة والمُتَع العابرة .
• حصر العلاقات الاجتماعية في أضيق حدودها.
• الاحتفاظ دائماً بمفكرة وقلم .
• تدوين الملاحظات والخواطر والتعليقات أولاً بأولٍ مهما كانت قيمتها وأهميتها.
وقد قرأت له مقالاً رائعاً في أسلوبه؛ عميقاً في مضمونه؛ جاء تحت عنوان: “المفكرة والقلم طريق النجاح” وهو يدور في مجمله حول هذه الفكرة التي نعرض لها الآن؛ كان بودي أن أنقله هنا كاملاً؛ ولكني أجتزئ منه هذه الفقرات المضيئات:
“التربية الإسلامية تجعل الفرد المسلم، مستقيماً واضحاً، في كلامه وسلوكه ومنهجه، حتى يصل إلى الصدق في القول والفعل بوصف “الصدق” سمة عامة، وطبيعة ذاتية في المسلم، لا تعرضه للمؤاخذة، أو تسحب الثقة منه أو تضعفها.
إن كثرة الشواغل والالتزامات تحتّم على المسلم أن يلتزم بما يقول أو يعد، وأن يرتّب وقته ترتيباً سليماً يضع في حسبانه المستجدات والطوارئ؛ ولذا فإن المفكرة التي على المكتب أو في حقيبة اليد، ومعها القلم الذي يسجل فيها المطلوبات والمواعيد الخاصة به، سواء على المستوى العام أو الصعيد الشخصي، تصبح ضرورة لازمة، حين ينظر فيها يتذكر ارتباطاته والتزاماته ليفي بها ويقوم عليها…..
إن قضية الوقت أو الزمن في حياة المسلم محسومة دينياً، فلا يوجد ما يسمى “وقت فراغ” بالنسبة له؛ إن وقته كله مشغول، وزمنه كله ممتلئ. هناك وقت للعمل، ووقت العبادات، ووقت الأسرة، ووقت المجتمع أو خدمة المسلمين، وإن تبقَّى بعد ذلك وقت فائض فهو للنوافل أو الذكر أو القراءة.. كثرة الالتزامات بالنسبة للمسلم لا تجعله يعيش في فراغ أبداً، وهو مطالب – كما يهديه الحديث الشريف – بالعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً، والعمل لأخراه كأنه يموت غداً.. فهل يبقى له بعد ذلك فراغ؟! إن استثمار الوقت فيما يفيد صاحبه والإسلام والمسلمين؛ يحتاج إلى إرادة قوية تنظم هذا الوقت، وتعتاد التنظيم، وترتضيه نمطاً يومياً للحياة ! ……
إن الذين يتعلّلون بضيق الوقت تسويغاً لتقصيرهم في العمل أو العلاقات الاجتماعية أو الالتزامات الشخصية مخطئون.. ويحتاجون إلى المفكرة والقلم إذا كانوا حقاً مخلصين ” !
أمَّا كيف يمسك بالقلم ويكتب ؛ فهذا شأن آخر ، وأيُّ شأن ! ؛ مرجعه إلى أصالة الموهبة وطول الدَّربة ؛ وهو ما يحتاج فيه الكاتب إلى ثقافةٍ جامعة وخبرة بفنون الكلام ، وإلى معجمٍ لغوي واسع يعينه على سوق الكلام لمرادات عقله ، وتصريف العبارة لحاجات فكرته .
ولا أحدثك عن تخطيطه للكلام كيف يبدأ وكيف ينتهي ؛ ولا عن تصوره للقضية كيف تظهر وكيف تكتمل ، ولا عن الدراسة كيف تتجلَّى فكرةً حتى تستوي كتاباً ؛ فهذا أمرٌ يفرض علينا أن نعرف كيف يتوقد خاطره ، وكيف يشتغل ذهنه ، وكيف يعمل عقله ، وهو ما يطول شرحه ويصعب بيانه في الصفحات القصار ، ولعلك تجد توضيحاً له فيما يأتي من القول !
***
• الرواية التاريخية في أدبنا الحديث :
حين هممت بكتابة هذه المقالة كانت نيتي أن تكون نواةً لدراسةٍ مطولةٍ تتناول سيرة أستاذنا ومسيرته ، وتعرض بالتفصيل لإسهامه العلمي وإنتاجه الإبداعي ، وتلقي الضوء على جهوده الصحفية والثقافية …. وهو ما اضطلعتْ به بعض مباحث هذا الكتاب ، وقام به الأساتذة والزملاء خيرَ قيام . وكان عليَّ أن أحدِّد لتقوية فكرتي وتأكيدها مثالاً واحداً على الأقل من كتب الدكتور حلمي ؛ وهي كثيرةٌ ومتنوعة ، ويحار المرءُ أمامها : ماذا يأخذ وماذا يدع ؟ ولكنني أدركتُ شيئاً عجيباً ؛ لعله من أسرار الكتابة وخصائصها عند هذا الرجل : وهي أن كتبه ومقالاته على اختلاف مضمونها وتباين أشكالها ؛ ترتبط كلُّها برباط فكريٍّ واحد ؛ وتسيطر عليها جميعها روح واحدة ؛ وتوشك أن تكون ، من أولها إلى آخرها ، مثالاً مرسوماً وعِقداً منظوماً لثلاثية ثالثة هي : الصدق ، والإخلاص والشجاعة !
تذكرت في البداية قول الشاعر القديم :
تَكَاثرَتِ الظّبَاءُ على خِرَاشٍ *** فما يدري خِراشٌ ما يصيدُ
ولكنني لم ألبث أن استقر رأيي على واحدٍ من أحسن ما أخرجه أستاذنا ـ وكل ما أخرجه حسن ـ وهو كتابه الموسوعي عن “الرواية التاريخية في أدبنا الحديث: دراسة تطبيقية ” أقف عنده هنا بالمثال والنموذج كلَّ كلمة قلتها؛ والتي توشك سطوره قبل صفحاته أن تنبئ عن طبيعة كاتبه ومزاجه وثقافته، وتشير بوضوح إلى ميوله ومذاهبه واتجاهاته؛ وهو ما آمل أن أوفَّقَ في عرضه وتبيينه فيما بقي لي من سطور.
لا أريد أن أبدأ الحديث عن هذا الكتاب قبل أن أشير إلى أمرٍ يبدو صغيراً وهو كبير ، ويراه كثيرون عادياً وشكلياً، وأراه أنا فارقاً وجوهرياً، وهو أن أستاذنا يستهلُّ كتبه كلَّها بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه؛ وهذا ما يتجاهله أكثر الكاتبين في هذا الزمان، وهو ليس مجرد طلبٍ للبركة أو دعاءٍ بالتيسير، ولكنه يعكس طبيعة النفس المسلمة المؤمنة التي تستحضر ربها في كل ما تفعل، وتذكر اسمه في بدء كل عملٍ وختامه .
فرغ الدكتور حلمي من هذا الكتاب سنة 1990م، وتقدم به لينشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر المحروسة، ولأنه لم يكن من المقربين إلى ذوي السلطان والنفوذ، ولا من الذين يتزلفون إلى أصحاب القرار في (غابة النشر) ، كان عليه أن ينتظر ما يقرب من ثلاث عشرة سنة ليرى كتابه النور، ويخرج في ستمائة صفحة من القطع المتوسط ، في سلسلة ( كتابات نقدية ) .
وهذا الكتاب، حجماً ومادةً وأسلوباً، يُعَدُّ نسيجَ وَحْدِه بين الدراسات الأدبية التي تناولت فن الرواية التاريخية عندنا، والشيء من معدنه لا يُستغرب؛ فمؤلفه ناقدٌ أدبي متمرس، يحترف الكتابة الأدبية، دارساً ومبدعاً، منذ ما يقرب من نصف قرن ، وله في مجال الإبداع القصصي والروائي إسهاماتٌ أصيلةٌ ومتميزة، أرجو أن يكون لي معها عودةٌ في قابل الأيام. وهو إلى جانب هذا مقاليٌّ من الطراز الأول، وصاحبُ أسلوبٍ أدبيٍّ راقٍ، يجمع متمكناً بين سهولة اللفظ وأصالة التعبير، ويحتفظ لكلامه دوماً بموسيقى خفيةٍ ومحببة، تظهر أحياناً وعلى استحياء، دون تكلُّفٍ أو مبالغة .
وهذه مزيةٌ كبرى للكتاب في الحقيقة ؛ فالقراء الذين رُبِّيَت أسماعُهم وأذواقهم على جمال البيان العربي المشرق ، في بلاغته العالية وفصاحته السامية، وكُتِب عليهم مثلنا أن يتابعوا ما تخطه أقلام الكتبة والباحثين في مجال النقد الأدبي عندنا، وأوتوا حظاً من الجلَد على قراءته وتمحيصه ـ يتفقون في مجملهم على أن معظم ما يقرءونه لنقدة هذا الزمان يوشك أن يكون رطانةً أعجميةً وفهاهةً بربرية، ويجيء أغلبه وكأنه ترجمة ركيكة لنصٍّ أجنبي، حُرِم أصحابُه نعمة الإفصاح والتبيين ، وفقد كُتَّابُه حاسة الذوق والتمييز، فأتى أكثر كلامهم رديئاً ومبهماً، يدابر العربية ويخالفُ رُوحَها، وإن تلبَّسَ بردتها واستعارَ أحرُفَها، يروعك مظهره ويسوءك مخبرُه، وتسمع له جعجعةً ولكنْ لا ترى طِحنا!
ولن تفرغ من قراءة الصفحة الأولى من هذا الكتاب حتى ترتسم أمام ناظريك شخصية مؤلفه ؛ ويتبدى أمامك وكأنك تراه رأي العين، رجلاً محباً لأمته، غيوراً على تراثها وتاريخها ، لا يأبه بإعراض المعرضين، ولا يخاف كيد المغرضين، ولا يخشى حين يقول كلمته في الحق لومة لائم:
“أحسب أن موضوع هذا الكتاب قد يبدو غير مريح للبعض، نتيجة لموجات من الأفكار والرؤى، تحبذ الانفصال عن الماضي، وترفض التراث جملةً وتفصيلاً، وتلهثُ ـ عمداً أو تضليلاً ـ وراء كل ما تقذفه نوافذ الغرب الثقافية، حتى لو كان نفايةً موضعها صناديق القمامة .
وللأسف ، فإن هذه الموجات من الأفكار والرؤى يملك أصحابُها قدرةً ضخمةً على مخاطبة الجمهور العريض من الناس، بحكم سيطرتهم على أجهزة الإعلام ووسائل الاتصال الثقافي . ومع الإلحاح المستمر على أذن القارئ وعينه ، صار من الصعب الوقوفُ في وجه هذه الموجات ، أو السباحة ضد تيارها الهادر!
ولا أحسبني من أولئك النفر الذين يتراضخون أمام الأمر الواقع ، ويقبلون به على علاته ، ويتعايشون معه على توحشه وإرهابه ؛ فقد تعودت أن أدقق وأحلل، وأراجع وأقارن ، ثم أموِّن الرأي الذي أقتنع به عن يقين ، وأومن به عن وعي”.
قسَّم المؤلف كتابه القيم على ثلاثة أسفارٍ متمايزة، تحدث في أولها عن “رواية التعليم”، وهي لون من الحكْي الروائي الممتع، أبدعه أصحابه في الأصل ليعلموا التاريخ من خلال أسلوبٍ شائقٍ وجذاب، حتى يتغلبوا على جفاف المادة وجهامة المعلومات التي يقدمونها للقراء.
ونستطيع ، كما يرى الكاتب، أن نحصر هذا النوع من الرواية في ثلاثة اتجاهات:
أولها: رواية المعلومات التاريخية، وهي التي تتوسل بالأداء الروائي أو القصصي لتقديم المعلومات التاريخية بصورةٍ ميسَّرةٍ وممتعة، وكان نموذجها في الدراسة رواية “فتح الأندلس” لجرجي زيدان.
ثانيها: رواية تعليم الصياغة والأسلوب، وغايتها تقديم نماذج أسلوبية وتعبيرية من خلال الرواية التاريخية، وكان شاهدها رواية “هاتف من الأندلس” لعلي الجارم .
ثالثها: رواية الترجمة الأدبية، وهي التي تُعْنَى بالترجمة لشخصيات أدبية وشهيرة في تاريخنا العربي ، وكان مثالها رواية “أسامة بن منقذ” للدكتور أحمد كمال زكي، الذي رآه أستاذنا أولَ من كتب في هذا المجال، والحقيقة أن الأستاذ يوسف العش قد سبقه إلي ذلك بسنوات طوال حين أخرج كتابه “قصة عبقري” عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، في العدد الثاني والأربعين من سلسلة (اقرأ) الذي صدر عن دار المعارف في مايو سنة 1946م. وقد وقع أستاذنا على هذا الكتاب وأشار إليه ، ولكن في طبعته الدمشقية التي ظهرت سنة 1982م
ودرس المؤلف في السِّفر الثاني ما أطلق هو عليه “رواية النضج”، وهي التي تناولت التاريخ بأحداثه وشخوصه وملامحه تناولاً فنياً، وفقاً لأسس واضحة ومعروفة، توافَق عليها كتاب الرواية في الغرب، ونقلناها نحن عنهم في الشرق، واصطلحنا على اتباعها وتحكيمها فيما يُقدَّم من أعمال روائية. وساق للقارئ منها سبعة نماذج تطبيقية ؛ درسها بعمقٍ وعلى مهل ، وهي بترتيب الكتاب:
• “المهلهِل سيد ربيعة” لمحمد فريد أبو حديد.
• “على باب زويلة” لمحمد سعيد العريان.
• “الثائر الأحمر” لعلي أحمد باكثير.
• “أميرة قرطبة” لعبد الحميد جودة السحار.
• “الباحث عن الحقيقة” لمحمد عبد الحليم عبد الله.
• “ابن عمار” لثروت أباظة .
• “المنصورة” للدكتور محمد مصطفى هدَّارة.
أما السِّفْرُ الثالث والأخير فقد عرض فيه الكاتب بشيءٍ من التحليل والتفصيل لما سماه “رواية الاستدعاء”، وهي تعتمد ـ كما يقول ـ على اتخاذ التاريخ وسيلةً لمعالجة قضايا معاصرة، أغلبها يرتبط بالغايات الحضارية والسياسية ، دون التزام صارم بوقائع التاريخ . وقد يكتفي كاتب الرواية بخلق جو تاريخي يُشْعِر القارئ بأن موضوع الرواية يجري في مرحلةٍ تاريخية ما، دون أن يكون للموضوع أي أساسٍ من الحقيقة .
وقد يستدعي الكاتب الروائي شخصيةً تاريخية ويبعثها في الواقع، ويحركها، ويواجهها بالناس والأحداث، ليفسر موقفه من قضيةٍ ما، أو يشرح كيفية معالجتها والتغلب عليها والتخلص منها، أو بلورتها وتطويرها وإثرائها.
واكتفى المؤلف في هذا السِّفْر باختيار أربع روايات متميزة كنماذج لهذا النوع ، وهي: “أمام العرش” و”رحلة ابن فطومة” وكلتاهما لنجيب محفوظ، و”عمر يظهر في القدس” لنجيب الكيلاني، و”من أوراق أبي الطيب المتنبي” لمحمد جبريل.
وينتهي هذا الكتاب الثمين النادر بخاتمةٍ موجزة، تماما كما بدأ باستهلالٍ قصير، يلخص فيها الكاتب رؤيته وملاحظاته ، ويدعونا ـ قراءً ومبدعين ـ إلى أن نتوجه نحو الجوانب المشرقة والمضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية، بل في حياتها … وهي تفيض بنماذج كثيرة من الرجال والحوادث التي أثَّرَت في مسيرة الإنسانية ، وجعلت شمس الكرامة تشرق على البشرية دون منٍّ أو أذى ، وهذه النماذج منجمٌ ثَرٌّ للمعالجة الروائية خاصة والإبداع الأدبي عامةً .
خُطَّةُ المؤلف في هذا الكتاب بسيطة وواضحة ، ينطق بها العنوان الذي وضعه له؛ فهو، بحكم دراسة التطبيقية ومنهجها ، لا يُعنَى كثيراً بتتبع مسيرة الرواية التاريخية، نشأةً وتطوراً وازدهاراً، وإن كان هذا يجيء عرَضاً أو ضمنياً في توطئات بعض الفصول، وكان أكبر همه أن يقدم للقارئ أنماطاً ونماذج تمثل أهم أشكال الرواية التاريخية وأبرز اتجاهاتها.
وعند كل روايةٍ عرض لها الكاتب سوف تجد حديثاً ، يقصر أو يطول ، عن إبداع صاحبها وتوجهاته. لا يعرض الرواية أو يحللها فحسب، وإنما يتخذ منه داعيا للتعريض بالفساد الحاصل المتفشي ، ويجعلها مناسبةً للإسقاط على الواقع الآسن المتردي؛ وإليكم مثلاً مما كتبه في أول كلامه عن صاحب رواية “الثائر الأحمر”:
“علي أحمد باكثير، واحدٌ من بناة الأدب العربيِّ الحديث في معظم ألوانه وفروعه، وهو في مجال الرواية يقف في الصف الأول الذي يضم “نجيب محفوظ” و”محمد عبد الحليم عبد الله” و”عبد الحميد جودة السحار” و”أمين يوسف غراب” وغيرَهم . وقد آثر أن يتجه في كتاباته الروائية والمسرحية إلى التاريخ ، مَعيناً ثَرًّا يغترف منه الحوادث والظروف المشابهة لما تمر به الأمة العربية الإسلامية في العصر الحديث ، فيجد هناك الرحابة والقدرة على التعبير الحر الطليق الذي يتيح له أن يسكب على الورق ما يعتمل في نفسه من همومٍ وأشجان ، وآمال وطموحات ، يفرزها عصرُه وواقعُه .
وإذا عرَفنا أن الفترة الني عاشها “باكثير” ونضج فيها، كاتباً مبدعاً، وشاعراً متمرساً ، كانت حافلةً ومثيرة ، فضلاً عن مناخٍ عام كان يقف بالمرصاد لمحاولات التعبير التي تخالف ما هو سائدٌ في الساحة الإعلامية ـ عرفنا لماذا جنح “باكثير” إلى التاريخ يلبسه قناعاً يتحدث من ورائه بما يريد أو عما يريد ؛ ففي التاريخ ـ على كل حال ـ مساحةٌ آمنة ، وأكثر رحابة ، يستطيع الكاتب على أرضها أن يصول ويجول، دون أن تعترضه مخاوف أو محاذير ؛ فإن التاريخ حافلٌُ بالنماذج الساطعة التي يمكن أن تحتذى في الواقع المعاصر الذي يخلو منها، وتُصميه الهزائم والمحن، فلا يجد مفرًّا من الهروب إلى التاريخ كي يجد فيه السلوَى والتئام الجراح، ويستعد مرةً أخرى للمواجهة واتخاذ زمام المبادرة”.
لقد قرأتُ أكثر الروايات التي درسها أستاذي في كتابه، وأزعم أنني دققت في مطالعتها جيداً، ولي في بعضها آراء غيرُ التي ذهب إليها، بَيْدَ أنني أعترف بأنه قد وضع يدي على أشياء كثيرة فاتت علىَّ وأفلتت مني … بعضها يتصل بشخصية الروائي ومبادئه، وبعضها يتعلق بأسلوبه الفني وطريقته في صياغة الأحداث التاريخية وسرده … لكن أهمها في نظري هو ما يخص “منهج القراءة الأدبية”؛ فليس يكفي أن نذرع العمل من أوله إلى آخره لندَّعي أننا فهمناه واستوعبناه ، ولا يكفي أيضاً أن نحلل عناصره الفنية ومناحيه الجمالية لنزعم أننا قد أدركنا كُنْهَه وأحطنا بأسراره .
إننا يجب أن نقرأ “ما بين السطور”، ونعرف ما وراء الكلام، وأن نتجاوز ظاهر النصِّ إلى باطنه، دون إسرافٍ في الظن أو شطَحٍ في التأويل، وأن نضع العمل الأدبي في سياقه وموضعه ، وفي مكانه الصحيح من إبداع صاحبه الخاص وتاريخ الأدب العربي العام، وأن نتزود للقراءة الأدبية بحصيلةٍ معرفية واسعة، تمكننا من تذوق النص وتحليله والحكم عليه، وأن نكون شجعاناً في إعلان كلمتنا وإبداء آرائنا، دونما غرور ولا عُنجهية؛ فالقراءة ليست ترفاً ولا تزجية فراغ، لكنها أمانةٌ ومسئولية ، والباحث الجاد في النهاية قارئٌ لقارئ ، وعليه أن يَصْدُقَه في كل كلمةٍ يكتبها ، والناقد مؤتمن ، والرائد لا يكذب أهله كما يقال .
إن كتابَ أستاذنا عن الرواية التاريخية ، خزانة حائكٍ بارع ، وخبرة ناقدٍ بصير ، يعشق تاريخ أمته ، ويفخر بانتمائه إليها ، ويحرص دوماً على أن يصل طلابه وقراءه بتراثها الرائع وماضيها المجيد . والذين يعرفونه أستاذاً أو يخالطونه إنساناً ، يدركون مدى حبه الصادق لكل ما هو عربي وإسلامي ، وإن له في ذلك لآياتٍ بيِّناتٍ من الدراسات الأدبية الإسلامية الرصينة ، والمواقف الفكرية الوطنية العظيمة … آمل أن آتي القارئ ببعض أخبارِها بعد حين .
***